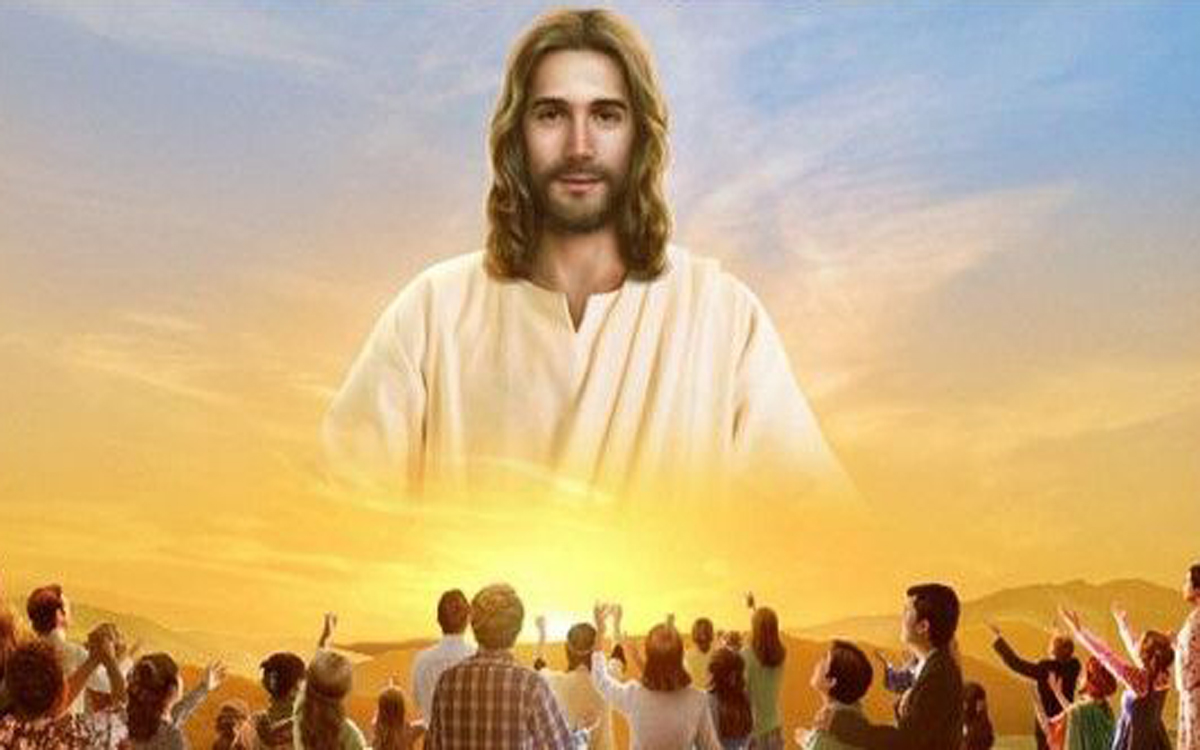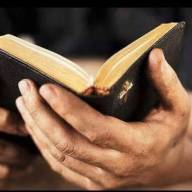الرغبة في تغيير الإنجيل
بقلم فيل جونسون
وهناك الرغبة الجسدية الثانية التي تسبِّب انحراف الكارزين عن الرسالة المسيحيّة النقيّة وهي الرغبة الملحة في التغيير «غَيْرَ أَنَّهُ يُوجَدُ قَوْمٌ يُزْعِجُونَكُمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُحَوِّلُوا إِنْجِيلَ ٱلْمَسِيح»(غلاطية 1: 7). أوضح الرّسُول بُولُس أن هؤلاء المعلِّمين الكذبة كان لديهم دافع شرير، نابعٌ من رغبة شريرة. فقد كانت لديهم خطة مرسومة مسبقًا بأن يشوِّهوا الإنجيل، ويحرِّفوه.
لستُ أظن أن الرّسُول بُولُس كان يقصد هنا بالضرورة أن يوحي بأن هؤلاء الأشخاص كانوا متآمرين عن وعيٍ مع الشيطان، وراغبين في أن يكونوا أشرارًا، ومتآمرين عن عمدٍ لفعل الشر، بدافع بغضتهم التامة للمسيح. فعلى الأرجح، لم يحسب هؤلاء أنفسهم أعداءً للمسيح، بل داخل عقولهم المضلَّلة، والمظلمة روحيًّا، كانوا يعتقدون، على الأرجح، أنهم يُجرون تحسينات على الإنجيل، ليجعلوه أكثر تناغمًا مع ناموس موسى، وينزعوا وصمة عار خطيرة عن المهتدين من الأمم، ويعالجوا ما اعتبروه موطن خلل ظاهرًا في تعليم الرسول بولس.
لم تكن مشكلة هؤلاء تكمن فقط في التلهُّف إلى شيء جديد. ربما كان انجذاب أهل غلاطية إلى كلِّ ما هو جديد هو ما جعلهم عرضة بشدّة للتعليم الكاذب؛ لكن، كان غرض أهل الختان مختلفًا. فقد أرادوا الاحتفاظ بعناصر من العهد العتيق كان قد انتهى أمرها. ومن ثَمَّ، فقد انتابتهم رغبة ملحة في إجراء تعديلات على الإنجيل، ربما لابتكار رسالة من شأنها أن تكون أكثر قبولًا لدى كهنتهم وعلمائهم. فقد أرادوا شيئًا أكثر تطوُّرًا من تلك الرسالة البسيطة عن الخلاص بالنعمة وحدها وبالإيمان وحده بواسطة المَسِيح وحده. وأرادوا أن تكون ديانتهم أكثر لمعانًا، وزخرفة، وإرضاءً للكبرياء البشري.
هذا الإلحاح الذي تمارسه الرغبة في التغيير هو سبب ضياع وخراب الكثيرين اليوم في الأوساط الأكاديمية. ففي هذه الأيام، إن كتب طالب في كلية لاهوت ورقة بحثية عن أية عقيدة من العقائد الرئيسية للإنجيل، سيُحَث، على الأرجح - بل وقد يُطالَب رسميًّا - بأن يبتكر وجهة نظر جديدة، أو يُقدِّم حُجَّة ضد مبدأ بارز لم يقدِّمها أحدٌ قبلًا. ففي جزء كبير من العالم الأكاديمي، يبدو أن الفلسفة التي صارت سائدة هي: «إذا لم يكن الشيء جديدًا، فهو بلا قيمة».
ولذلك، يبتكر «اللاهوتيون الإنجيليون»باستمرار، ظاهريًّا، وجهات نظر جديدة، وعقائد معدَّلة. بل وقد صارت أكثر المبادئ الأساسية والراسخة منذ زمان طويل بشأن الثالوث تخضع اليوم، في طيشٍ، للترميم وإعادة الصياغة المستمرة. هذا نتاج فكر ما بعد الحداثة. لم يَعُد شيء يُحسَب أكيدًا، أو محسومًا، أو موثوقًا بالحقيقة. يمكن اليوم إعادة النظر في أيِّ شيء، وكل شيء، وإعادة صياغته، وتحريفه، وتغييره. بل وفي بعض الأحيان، يبدو حتى الذين يقال عنهم إنهم لاهوتيون إنجيليون محافظون أنهم مصابون بشعور لا يهدأ يلحُّ عليهم بتغيير إقرارات إيمانهم.
بقدر الخطر الذي شكَّله أهل الختان، لكنهم لم يكونوا متهوِّرين بشكل زائد عن الحد. ففي حقيقة الأمر، يبدو التغيير الذي أجروه على إنجيل الرّسُول بُولُس تافهًا إلى حد كبير بحسب مقاييس هذه الأيام. فهم لم يشكِّكوا في سُلطة الكتاب المقدس، أو يرفضوا مبدأ احتساب برِّ المسيح، أو يشنوا هجومًا مباشرًا على مفهوم الكفارة البدلية. لكن، لم يتعدَّى ما افترضوه كونه تغييرًا طفيفًا في «ترتيب الخلاص»[ordo salutis]. فقد ظنوا أنه من الضروري أن يسبق التبرير عملٌ صالحٌ من نوع ما.
علَّم الرّسُول بُولُس بأن الأعمال الصالحة تنبع من الإيمان الذي للخلاص، وليس العكس. ومن ثَمَّ، يتبرر الخاطئ تمامًا منذ اللحظة الأولى من الإيمان؛ وبعد ذلك، تأتي الطاعة كثمرٍ حتميٍّ للإيمان الحقيقي. وقد شدَّد الرّسُول بُولُس مرارًا على أن الإيمان وحده هو الأداة التي بها يتبرَّر الخطاة؛ وهذا ما قاله بكلِّ صراحة في رومية 4: 5، «وَأَمَّا ٱلَّذِي لَا يَعْمَلُ، وَلَكِنْ يُؤْمِنُ ... فَإِيمَانُهُ يُحْسَبُ لَهُ بِرًّا». وهكذا، يأتي التبرير أولًا، ثم الأعمال.
لكن، رفض أهل الختان ذلك، وقالوا إن تعبيرًا بسيطًا عن الطاعة – من خلال ذلك الفعل الأول من طاعة الناموس الطقسي – شرطٌ أساسي للتبرير. إذن، تأتي الطاعة أولًا، ثم التبرير.
اتفق كلا الطرفين معًا على أنَّ الإيمان دون أعمال ميت، وآمن كلاهما بأن الإيمان والطاعة دائمًا ما سيصاحبان الخلاص الحقيقي؛ لكنهما اختلفا معًا حول الترتيب.
بحسب المقاييس الرائجة اليوم، ربما يبدو هذا اختلافًا شديد التفاهة، غير جدير بأن يثير قلقنا. فإليك ما قاله ج. جريشام ماتشين (J. Gresham Machen) بشأن ذلك:
كان المهوِّدون متفقين تمامًا مع الرّسُول بُولُس حول كثير من الأشياء. فقد آمنوا بأن يَسُوع ÂÂÂ هو المسيَّا ... وبأنه حقًّا قام من الأموات. وآمنوا ... بأن الإيمان بالمَسِيح ضروريٌّ للخلاص ... وبحسب الفكر الحديث، يبدو لنا الاختلاف [بينهم وبين بولس] طفيفًا للغاية ... قطعًا، كان ينبغي أن يقف الرّسُول بُولُس على أرض مشتركة مع هؤلاء المعلِّمين الذين كانوا متفقين معه بشكل كبير جدًا. وقطعًا، كان ينبغي أن يطبِّق عليهم مبدأ الوحدة المسيحية العظيم.[1]
لكن، تابع ماكين قائلًا: «لم يفعل الرّسُول بُولُس شيئًا من هذا القبيل؛ وفقط لأنه ... لم يفعل شيئًا من هذا القبيل، ما زالت الكنيسة المسيحية موجودة اليوم».[2]
فما بدا أنه نقطة خلاف تافهة كان، في حقيقة الأمر، هجومًا مكثَّفًا على محور الإنجيل. فقد جعل أهل الختان التبرير متوقِّفًا على عملٍ ما يعمله الخاطئ. وهذا التعديل الذي يبدو طفيفًا قضى على رسالة الإنجيل بأكملها.
يحدث ذلك كلما قرَّر أحدهم أن الإنجيل ليس متطوِّرًا بما يكفي، أو ليس أكاديميًّا بما يكفي، أو متزمتًا بما يكفي. وحين يبدأ الناس في إجراء تعديلات على الإنجيل، يضيفون دائمًا إلى المعادلة عملًا من نوعٍ ما. قد يكون هذا العمل بسيطًا، مثل التقدُّم إلى الأمام في الكنيسة، أو ترديد صلاة مكتوبة، أو المعمودية، أو ممارسة أي مطلب طقسي بسيط آخر. إلا أنَّ جعل أي عمل بشري من أيِّ نوعٍ ضروريًّا للتبرير يقضي على العقيدة تمامًا.
فإن الإيمان الحقيقي الذي للخلاص هو النتيجة الطبيعية للولادة الثانية من الله. فإن الله هو الذي يفتح الأعين التي أصيبت بالعمى الروحي، ويهب التوبة، ويوقِظ الإيمان. فإن الولادة الثانية، والإيمان، والتوبة جميعها من صُنع نعمة الله. ليست هذه أعمالًا بشرية، كما قال الرّسُول بُولُس في أفسس 2: 8-9، «لِأَنَّكُمْ بِٱلنِّعْمَةِ مُخَلَّصُونَ، بِٱلْإِيمَانِ، وَذَلِكَ [كل جانب من جوانب الخلاص] لَيْسَ مِنْكُمْ. هُوَ عَطِيَّةُ ٱللهِ. لَيْسَ مِنْ أَعْمَالٍ كَيْلَا يَفْتَخِرَ أَحَد». هذه هي العقيدة المحورية في حق الإنجيل. وإن التعديل الطفيف والتافه الذي أجراه المهوِّدون قد أبطله تمامًا، لأنهم استبعدوا الحق الأساسي القائل إن كلَّ عنصر من عناصر الخلاص ليس من عمل بشري.
إذًا، من جهة الإنجيل، هذه الرغبة الملحة في التغيير خطية تستحق اللعنة!