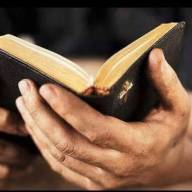أوّلًا، كان الميلاد العذراوي هو الآية التي أعطاها الله لكي يلفت الانتباه إلى كون يسوع المسيح هو تتميم العهد الداودي(انظر إشعياء 7: 14؛ متّى 1: 23؛ لُوقا 1: 32-33)، ففي كل من إنجيل متّى وإنجيل لُوقا، توجد صلة وثيقة بين ميلاد المسيح والوعد العهدي الذي قطعه الرب مع داود. ورد الاستخدام الوحيد في بشارة متّى لكلمة «عذراء»في اقتباسه من نبوة إشعياء 7: 14 مُشيرًا إلى تتميمها (متّى 1: 23). أعلنت هذه النبوة عزم الله على تتميم عهده الذي أقسم به لبيت داود، من خلال ابن يُحبَل به ويُولَد من عذراء،
سيكون هو الله الظاهر في الجسد. وهكذا، اعتُبر الميلاد العذراوي ضرورة إلهيّة مُتضمَّنة داخل قصد الرب بأن يأتي في النهاية بواحد من نسل داود ليملك على كلٍّ من إسرائيل والأمم (إشعياء 9: 6-7). بدون الميلاد العذراوي، يصير العهد الداودي لاغيًا وباطلًا. لكن الحقيقة التاريخيّة للميلاد العذراوي تعني أن الرجاء في أن يقيم الرب يومًا عرشه على الأرض[1] من خلال هذا النسل الداودي، أي يسوع، ما يزال ممكنًا، وأنه سيصير حقيقة حين يأتي يسوع ثانية (متّى 25: 31). ومن ثَمَّ، فإن الإيمان بالميلاد العذراوي للمسيح أمر حيوي في الرجاء الأخير للمؤمن.
أظهر لُوقا أيضًا وجود صلة وثيقة بين الميلاد العذراوي وتتميم العهد الداودي. إن الاستخداميْن لكلمة «عذراء»في إنجيله وردا في أثناء روايته للكيفيّة التي أُرسِل بها جبرائيل من الله ليتكلَّم إلى مريم، التي كانت آنذاك مخطوبة ليُوسف، الذي كان من بيت داود (أي من نسل داود). وكانت ذروة بشارة جبرائيل لمريم هي أن ابنها يسوع الذي سيُحبَل به ويُولَد من عذراء سيكون هو التتميم للعهد الداودي (1: 32-33). سيكون يسوع هو ابن الله، وابن داود أيضًا، الذي سيُعطيه الرب الإله كرسي داود، الذي سيملُك من فوقه على بيت يعقوب إلى الأبد. إنه مَن سيكون الحاكم الداودي الذي لن يكون لمُلكه نهاية. وكما في إنجيل متى أيضًا، أكَّد لُوقا الصلة الوثيقة بين الميلاد العذراوي والتتميم الأخير للعهد الداودي. وهكذا، يتبيَّن، مرّة أخرى، أن الحقيقة التاريخيّة للميلاد العذراوي أساسيّة للرجاء الأخروي للمؤمن.
ثانيًا، كان الميلاد العذراوي هو الوسيلة التي اختارها الله لكي يدخل بها المُخلِّص إلى العالم (متّى 1: 21، 23؛ لُوقا 1: 32، 68-75؛ 2: 11). كان ينبغي لذلك الابن المولود من عذراء أن يُدعَى يسوع، لأنه يخلِّص شعبه من خطاياهم (متّى 1: 21). يصحبنا هذا إلى نبوة العهد القديم القائلة إن ذاك الذي سيكون مسيا إسرائيل سيكون أيضًا فادي إسرائيل ومخلِّصها (إشعياء 49: 5؛ 52: 13-53: 12). كان الميلاد العذراوي هو الوسيلة التي اختارها الله لكي يدخل بها المُخلِّص إلى العالم. أكَّد كل من زكريا (لُوقَا 1: 68-75)، والملاك (لُوقَا 2: 11) أن يسوع دخل إلى العالم لكي يُدبِّر الخلاص لإسرائيل، ولجميع من سُرَّ بهم الله. طُرح قبلًا هذا السؤال: هل كان الله يستطيع أن يُدخِل الإله-الإنسان إلى العالم بأيّة وسيلة أخرى؟ والإجابة هي: لا نعرف. لكن ما يقوله الكتاب المُقدّس هو أن هذه كانت الوسيلة التي اختارها الله. لقد كانت لديه القدرة على أن يرى كافة الاحتمالات والأمور الممكنة، وكانت هذه أفضل الوسائل التي توافقت مع اختياراته الحُرّة وخططه الأزلية. كان الميلاد العذراوي هو الوسيلة التي لا بد أن يدخل بها مُخلِّص شعبه، أي المنقذ، وحامل خطاياهم، إلى العالم.
طُرح قبلًا هذا السؤال: هل كان الله يستطيع أن يُدخِل الإله-الإنسان إلى العالم بأيّة وسيلة أخرى؟ والإجابة هي: لا نعرف. لكن ما يقوله الكتاب المُقدّس هو أن هذه كانت الوسيلة التي اختارها الله. لقد كانت لديه القدرة على أن يرى كافة الاحتمالات والأمور الممكنة، وكانت هذه أفضل الوسائل التي توافقت مع اختياراته الحُرّة وخططه الأزلية. كان الميلاد العذراوي هو الوسيلة التي لا بد أن يدخل بها مُخلِّص شعبه، أي المنقذ، وحامل خطاياهم، إلى العالم.
ثالثًا، أتاح الميلاد العذراوي أن يُولَد يسوع من الله(التكوين 5: 1؛ متّى 1: 1؛ لُوقا 1: 35؛ 3: 38)، بلا خطيّة (التكوين 1: 27، 31؛ لُوقا 1: 35). من المثير للاهتمام أن يضع متى هذا العنوان لإنجيله: «كِتَابُ مِيلَادِ يسوع ٱلْمَسِيحِ ٱبْنِ دَاوُدَ ٱبْنِ إِبْراهِيم»(1: 1). يُردِّد هذا العنوان صدى التكوين 5: 1 الذي يقول: «هَذَا كِتَابُ مَوَالِيدِ آدَم»، ففي حقيقة الأمر، كانت العبارة الأولى من متّى 1: 1 تكرارًا دقيقًا للعبارة الأولى من التكوين 5: 1، عدا أن الكلمات «يسوع المسيح»قد حلَّت محل كلمة «آدم». يُبيّن هذا التوازي وجود تشابه وتناقُض بين يسوع وآدم. لقد «وُلد»كلاهما من الله بشكل فريد، بحيث دُعيا «ابن الله»في الحالتين (يسوع في لُوقا 1: 35؛ وآدم في لُوقا 3: 38). اشترك آدم ويسوع معًا فيما لا ينطبق على أي إنسان آخر: فقد جاء كلاهما إلى الوجود دون تدخل رجل. وبما أنهما «وُلدا»من الله نفسه، فقد جاءا أيضًا إلى العالم بلا خطيّة. ولكن، يوجد أيضًا اختلاف شديد بين الاثنيْن، ففي حين ذُكر آدم أولًا في سلسلة نسب الفصل الخامس من سفر التكوين، ذُكر يسوع أخيرًا في سلسلة نسب الفصل الأوّل من إنجيل متّى. في الفصل الخامس من سفر التكوين، مات جميع نسل آدم، عدا واحد (أخنوخ)، إذ انتقلت الخطيّة والموت من آدم إلى ورثته. لكن في يسوع، ومن خلال موته بالجسد، يمكن أن يتحقّق الخلاص من الخطيّة الموروثة من آدم (متّى 1: 21).
رابعًا، نتج عن الميلاد العذراوي حُلول الله بين البشر في جسم بشري (متّى 1: 23؛ يُوحنّا 1: 1، 14)، وكان هو الوسيلة التي بها يمكن لله السابق الوجود أن يتخذ جسدًا مع الاحتفاظ بطبيعته الإلهيّة. فبحسب يُوحنّا 1: 14، الكلمة (الذي كان هو الله؛ يُوحنّا 1: 1) صار جسدًا – أي صار الله إنسانًا. يُعرَف هذا باسم التجسُّد. وكما يروي الكتاب المُقدّس، حدث هذا التجسد بواسطة الحبل العذراوي، إذ أوجد الله الروح القدس الجنين في رحم عذراء تُدعَى مريم. بعد هذا الحبل، اتَّبع نمو الجنين يسوع وميلاده نمط الحبل والميلاد الطبيعي لأي إنسان آخر. وهكذا، استطاع الإله الأزلي (يُوحنّا 1: 1) الدخول إلى العالم ليس كإله كامل فحسب، بل أيضًا كإنسان كامل. لقد كان شخصًا واحدًا، الله والإنسان معًا، وكان هذا نتيجة الميلاد العذراوي، أي تجسد الله.
خامسًا، كان الميلاد العذراوي شهادة عن قُدرة الله على فعل ما يستحيل على الإنسان فعله (لُوقَا 1: 37). قال الملاك جبرائيل: «لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ غَيْرَ مُمْكِنٍ لَدَى ٱلله»(لُوقَا 1: 37). تضمَّن هذا منح أليصابات التي كانت قد اجتازت عُمر الإنجاب ابنًا من زوجها، زكريا، ومنح مريم حَبَلًا دُون رجل من البشر، عن طريق الميلاد العذراوي. كانت هاتان المعجزتان عمليْن ضمن الكثير من أعمال الله القديرة التي صنعها عبر التاريخ، والتي يُسجِّلها لنا الكتاب المُقدّس، ففي عالم خلقه الله، يستطيع هذا الخالق أن يفعل ما يستحيل على الإنسان فعله.
سادسًا، يختبر الميلاد العذراوي فِكر علماء اللاهوت من منطلق افتراضات المذهب الطبيعي، أم في انفتاح على ما هو فوق الطبيعة. إن حَبَل امرأة بطفل دون رجل هو شيء مستحيل بحسب الطبيعة. ومن ثَمَّ، فإن كان أي عالم لاهوت أو أي علم لاهوت يتبع افتراضات المذهب الطبيعي البحتة، فسيكون الميلاد العذراوي مستحيلًا – مثله مثل القيامة بالجسد من الأموات. ولكن المؤمن الخاضع لما يقوله الكتاب المُقدّس يتبنّى نظرة وفلسفة حياتيّة تؤكِّد أن الإله الخالق يتدخّل في التاريخ البشري في بعض الأحيان ليفعل ما هو مستحيل بالطبيعة. إن كان أحدهم يُؤمن بما هو فوق الطبيعة فلن يُعاني من مشكلة في قُبول الميلاد العذراوي. وأيضًا، إن كان أحدهم يقبل خُلو الكتاب المُقدّس من الخطأ، فلن يُعاني من مشكلة في التصديق على الميلاد العذراوي باعتباره حقيقة. إن استنتاجات المرء بشأن الميلاد العذراوي تكشف أساس فكره اللاهوتي، وما إن كان يقبل الإعلان الإلهي فوق الطبيعي أم المنطق الطبيعي.
سابعًا، ينبغي أن يكون الميلاد العذراوي جُزءًا من إقرار إيمان المؤمن (1تيموثاوس 3: 16؛ عبرانيّين 2: 14؛ 1 يُوحنّا 4: 1-3).خلال القرنيْن الماضيّيْن، ثار كثير من الجدل حول ما إن كان الميلاد العذراوي قد حدث بالفعل أم لا، بل وثار جدل أكبر حول ما إن كان يلزم على المرء لكي يصير مؤمنًا مسيحيًّا أن يؤكد إيمانه بالصحّة التاريخيّة للميلاد العذراوي. ارتكز الإعلان الرسولي لرسالة الإنجيل في سفر أعمال الرسل على الحقيقة التاريخيّة بأن يسوع هو المسيا (المسيح)، الذي، كإنسان، مات، ثم أقيم من الأموات (2: 29-36؛ 3: 12-16؛ 5: 27-32؛ 10: 34-43؛ 13: 26-41؛ 17: 2-3، 30-31). أيضًا أكَّد الرّسُول بُولس حقيقة موت يسوع وقيامته من الأموات في الموجز الذي قدَّمه لرسالة الإنجيل، وسلَّمه إلى أهل كورنثوس (1كورنثوس 15: 3-8). صِدقًا، وبحسب ما نجده في الأسفار القانونيّة للعهد الجديد، لم تَذكُر الكرازة الشفهيّة بالإنجيل شيئًا عن الميلاد العذراوي. لكن لم يكن العهد الجديد بصامت عن حاجة المؤمنين المسيحيّين إلى الإقرار بأن يسوع كان إنسانًا حقيقيًّا من لحم ودم، مما يشمل بداخله ضمنًا أنه جاء إلى الجنس البشري عن طريق الولادة مثله مثل أي إنسان آخر (راجع رُوميَة 1: 3؛ غلاطيّة 4: 4). يُبيِّن نص 1يُوحنّا 4: 1-3 أن المؤمنين المسيحيّين الحقيقيّين كانوا يُعلِّمون ويُقرُّون بأن «يسوع ٱلْمَسِيحِ ... قَدْ جَاءَ فِي ٱلْجَسَد»(4: 2 ب). كان إنكار هذا الحق دليلًا على أن المرء ليس من الله. وهكذا إذًا، كان إقرار الإيمان بالولادة البشريّة ليسوع أحد الأشياء التي تُميِّز المؤمنين الحقيقيّين عن المُعلِّمين الكَذَبة وأتباعهم (1تيموثاوس 3: 16؛ عبرانيّين 2: 14-18). لقد كان الإقرار بالناسوت الكامل ليسوع، بالإضافة إلى لاهوته الكامل، عنصرًا أساسيًّا في الإيمان المسيحي. ولكن، لم يكن الميلاد العذراوي، باعتباره الوسيلة التي استخدمها الله لكي يُولد بها يسوع، جُزءًا صريحًا من الكرازة بالإنجيل، ولم يكن كذلك من أقدم إقرارات الإيمان المَسيحيّة في القرن الأوّل.
لكن بحُلول القرن الثاني، تغيَّر الوضع؛ فمن بين أقدم إقرارات إيمان كنيسة ما بعد الرسل، كان هناك ما يُسمَّى «قانون إيمان الرسل». أشار إيريناؤس وترتليانوس إلى قانون الإيمان هذا في الجزء الأخير من القرن الثاني. فبحلول ذلك الوقت، كان هذا القانون قد أصبح جُزءًا من الكنيسة الغربيّة على الأقل؛ وكان كل مَن يأتي إلى الإيمان لا بُد أن يُقر به قبل المعموديّة. تضمّنت النسخة الأقدم من قانون الإيمان هذا الكلمات التالية: «مولودًا من الروح القدس ومن العذراء مريم»، إن لم يكن قد تضمّن التصريح الكامل المستخدَم اليوم: «الذي حُبِل به من الروح القدس، والمولود من العذراء مريم».[2] ومن القرن الثاني وحتى القرن الحادي والعشرين، ظل الإقرار بالميلاد العذراوي جُزءًا أساسيًّا من الإيمان المسيحي، بناء على براهين العهد الجديد. وبهذا، يَلزَم على جميع المؤمنين المعترفين الإقرار بصحّة الميلاد العذراوي كجُزء من البراهين التي تضمن أنهم بالحقيقة أبناء الله الذين قد نالوا فداءً.
ختامًا نقول، إنه بحسب العهد الجديد، لم تتضمّن رسالة الإنجيل التي كُرِز بها شفهيًّا أيّة إشارة إلى الميلاد العذراوي ليسوع. وهكذا، يمكن الاستجابة بإيمان للخلاص دون الإقرار بصحّة الميلاد العذراوي. ولكن ينبغي افتراض أن مؤمنًا قد نما في إيمانه، وتعلَّم المزيد عن يسوع، يشهد بالفعل عن صحّة الميلاد العذراوي. إن آمن أحدهم بقيامة يسوع من الأموات (وهي معجزة عظيمة)، فلا توجد أيّة مشكلة منطقيّة في أن يؤمن بالمعجزة التي تُساويها في العظمة، أي معجزة ميلاده العذراوي. إن الميلاد العذراوي للمسيح مسألة ضروريّة بصُورة مُطلقة للإيمان المسيحي.