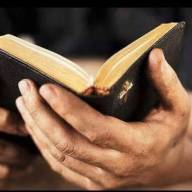الاعتراف الحسن
بقلم القس أشرف بشاي
عزيزي القارئ اسمح لي أن أسألك: أين تسكن؟
هل تسكن في مدينة أم في قرية بسيطة؟
هل مدينتك تقع على ساحل البحر أم أعلى الجبل؟
هل مُناخ البلد الذي تسكن فيه حارٌ جدًا، أم باردٌ جدًا، أم معتدل لطيف؟
لقد لاحظ عُلماء الكتاب المقدَّس ارتباطَ الجغرافيا بحالة الإنسان النفسيّة من شقاء أو سعادة؛ فلفتوا انتباهنا إلى أن الله خلق الإنسان ووضعه في «جنة» (جنّة عدن) ليعملها ويُفلحها. فالجنة هي المكان الذي لاقَ بالله أن يصنع إذ أراد إسعاد الإنسان؛ تاج خليقته، أمّا كومة الرماد فهي تُناسِب إنسانًا يعاني الاكتئاب والحزن العميق (كأيوب). وجبل الكرمل هو المكان المناسب لتحقيق الانتصار على أنبياء البعل بما يتبع ذلك من مشاعر الفرح ومظاهر الاحتفال، لكن مغارة الجبل هي أفضل مكان لشخص خائف ومأسور لمشاعر اليأس كإيليا. إن الصحراء باتساعها هي أفضل مكان للحصول على صفاء الذهن، ونقاء السريرة، والتحلُّل من أعباء الحياة من طعام وشراب وتحديات، لذا عاش يوحنّا المعمدان في الصحراء طيلة حياته مُتوحِّدًا، كذلك إليها ذهب شاول الذي صار فيما بعد بولس الرسول، لكي يُراجع ما سبق أن تعلَّمه عن مسيّا الله في العهد القديم، ولكي يفحص إن كانت مواصفات هذا المسيّا تنطبق على يسوع؛ نجّار الناصرة، أم لا. وهكذا فكلّما كان المكان الذي يعيش فيه الإنسان جميلًا كُلما قاده ذلك إلى الاستمتاع بالله الخالق الذي أوجد، بمحبته وقدرته، هذا الجمال، لكي يقود الإنسان إلى رؤية نفسه كجزء من مقاصد الله نحو هذا العالم، وهو الأمر الذي يجلب الفرح والسكينة والصفاء للحزانى والمضطربين ولمُشوشي الذهن.
كتب البشير متّى قائلًا:
«وَلَمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى نَوَاحِي قَيْصَرِيَّةِ فِيلُبُّسَ سَأَلَ تَلاَمِيذَهُ قِائِلًا: «مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِّي أَنَا ابْنُ الإِنْسَانِ؟» فَقَالُوا: «قَوْمٌ: يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ، وَآخَرُونَ: إِيلِيَّا، وَآخَرُونَ: إِرْمِيَا أَوْ وَاحِدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ». قَالَ لَهُمْ: «وَأَنْتُمْ، مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟» فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَقَالَ: «أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ الْحَيِّ!». فَأجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ: «طُوبَى لَكَ يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا، إِنَّ لَحْمًا وَدَمًا لَمْ يُعْلِنْ لَكَ، لكِنَّ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. وَأَنَا أَقُولُ لَكَ أَيْضًا: أَنْتَ بُطْرُسُ، وَعَلَى هذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْني كَنِيسَتِي، وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا. وَأُعْطِيكَ مَفَاتِيحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، فَكُلُّ مَا تَرْبِطُهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاوَاتِ. وَكُلُّ مَا تَحُلُّهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولًا فِي السَّمَاوَاتِ». حِينَئِذٍ أَوْصَى تَلاَمِيذَهُ أَنْ لاَ يَقُولُوا لأَحَدٍ إِنَّهُ يَسُوعُ الْمَسِيح» (متّى ١٦: ١٣- ٢٠).
إذًا، على أبواب مدينة قيصريّة فيلبس، البعيدة عن ازدحام منطقة الجليل، هذه المدينة الخضراء الجميلة، والتي بناها الوالي فيلبس قُرب منبع نهر الأردن لتُخلّد اسمَ الامبراطور الرومانيّ أغسطس قيصر، على أبواب هذه المدينة سأل يسوع تلاميذه: «من يقول الناس إني أنا؟» ثم أردف سائِلًا: «وأنتم من تقولون إنّي أنا؟». وبالطبع لنا أن نسأل: «لماذا يهتّم المسيحُ بآراء الناس فيه؟ هل كان سؤال المسيح عن رأي الناس فيه مُجرّد مقدِّمة ليسأل تلاميذه عن رأيهم هم فيه؟ هل هذا الاهتمام برأي الناس يتعارض مع قول المسيح نفسه: «ويل لكم إن قال فيكم جميعُ الناس حسنًا؟ (لوقا ٦: ٢٦)؟»
على أي حال، يبدو أن آراء الناس في المسيح رغم اختلافها لكنها جميعًا كانت تؤكّد أن المسيح احتل في القلوب والنفوس مكانة عالية. وكيف لا وقد كان المسيح عطوفًا ورقيقًا مع الخُطاة، والزناة، وجامعي الضرائب الذين نظر إليهم الناس على أنهم خونة، إذ كانوا يتعاونون مع المحتل الروماني. كان المسيح قريبًا من آلام الناس: شفى مرضاهم، وأقام موتاهم، وأشبع الجياع منهم، ومسح دموع الحزانى والثكالى. ما أحلى الكلمات التي كتبها الشاعر المسيحي حين قال:
عشتَ يا مولاي حينًا بينهم
تنزعُ البغضاء منهم والخصامَ
كُنت يا قدوسُ قلبًا مُشفقًا
فملأتَ الكونَ حُبَّا وسلامًا
كنتَ رِجلًا لكسيح ويدًا
لأشل وأبًا بين اليتامى
قد أقمتَ الميتَ والأعمى رأي
والطريحُ المُقعَد اشتدَ وقام
لقد كانت محبّة الناس للمسيح ردّا طبيعيّا وتلقائيًا لحُبّه السامي لهم ولتواضعه الجم، إذ وهو القدوس كان يُجالس الجميع، ويحنو على الجميع، ويُحبّ الجميع، بلا تفرقة ولا تمييز! لذا لا عجب أن أدرك البعض قيمة المسيح فوضعوه في مكانة يوحنّا المعمدان (أفضل المولودين من النساء بشهادة المسيح نفسه)، وإيليا وإرميا الذيْن كانت لهم المكانة السامية الرفيعة في قلوب الناس في ذلك العصر.
لكن المسيح عاود سؤاله للتلاميذ: «وأنتم من تقولون إني أنا؟» وكأن المسيح كان يسأل التلاميذ: «هل أنتم أيضًا تتفقون مع عامة الناس في الاعتقاد بأنني نبيّ أو أحد الأنبياء العظام؟» أجاب بطرس نائبًا عن التلاميذ قائلًا: «بل أنت هو المسيح ابن الله الحيّ». إنّ اسم المسيح أو المسيّا في العهد القديم لم يكن يشير إلى مجرّد نبيّ عادي (رغم عظمة الأنبياء)، قلا يمكن أن الجالس على (العروش – وليس العرش)، القديم الأيام، الذي له العرش كلهيب نار، الذي تخدمه ألوف ألوف، وتقف قدّامه ربوات ربوات من الملائكة رهنًا لإشارته .. لا يمكن أن يكون هذا الوصف الوارد في سفر دانيآل الأصحاح السابع وصفًا لنبيّ، بل هو وصف لمسيا الله الذي يحكم من العرش الإلهي، ويملك فوق الجميع.
هكذا اعترف بطرس بربوبيّة المسيح فاستحق التطويب الإلهيّ: يا لسعادتك يا بطرس، فقد سمعت وفهمت القول المبارك: «فبمن تشبِّهون الله، وأي شبه تعادلون به؟ .. فبمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس؟» (إشعياء ٤٠: ٩-١٢، ١٨، ٢٥). لقد أورد البشير متّى كلمة «طوبى» ثلاث عشرة مرّة، وهذه هي المرّة الأولى التي يُطوَّب فيها شخصٌ بمفرده. طوبى لك يا بطرس .. يا لسعادتك ويا لسعادة كل من يعرف هويّة المسيح. إن معرفته تعني معرفة الحياة واقتنائها.
لقد سمع الرسول بطرس شهادة أخيه أندراوس الذي عرف المسيح أولًا. شهد أندراوس قائلًا: «وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح» (يوحنا ١: ٤١-٤٢) وهكذا بدأ بطرس مسيرة إيمانه بالمسيح تابعًا لشهادة أخيه، لكن بطرس سرعان ما اختبر بنفسه قداسة المسيح الكاملة إذا عاين كمالَه الأخلاقي الذي لا تشوبه شائبة، كما عاين معجزاته التي لا مثيل لها، وسمع تعاليمه السامية التي لم تسمع الأذان البشرية لها من نظير. لقد تأكَّد بطرس أن ملكوت الله قد أتى في شخص المسيح، وأنّ الله بذاته قد اقتحم هذا العالم البائس لكي يصنع خلاصًا هذا مقداره. إنَّ أحد الأسئلة الكبيرة التي يتحدى بها المؤمنون بالمسيح كلَّ مقاوميهم هو: «لو أن الله دخل إلى عالمنا، فما الذي يمكن أن يصنعه؟» فكِّر قليلًا وأطلق لخيالك العنان وستجد أن كلّ دلائل الألوهيّة وأسمى مظاهرها قد تجلّت في شخص المسيح وحده وليس سواه!
هنا قال المسيح لبطرس: «إن لحمًا ودمًا لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات». في نهاية الأصحاح الحادي عشر رفع المسيح للآب السماويّ صلاةً مفادها: «أَحْمَدُكَ أَيُّهَا الآبُ رَبُّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، لأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هذِهِ عَنِ الْحُكَمَاءِ وَالْفُهَمَاءِ وَأَعْلَنْتَهَا لِلأَطْفَالِ. نَعَمْ أَيُّهَا الآبُ، لأَنْ هكَذَا صَارَتِ الْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ. كُلُّ شَيْءٍ قَدْ دُفِعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُ الابْنَ إِلاَّ الآبُ، وَلاَ أَحَدٌ يَعْرِفُ الآبَ إِلاَّ الابْنُ وَمَنْ أَرَادَ الابْنُ أَنْ يُعْلِنَ لَه» (متّى ١١: ٢٥-٢٧). لقد كشف الله لقلب سمعان بطرس هويّة المسيح وعرَّف هذا الكشف بطرسَ أن المسيح ليس مجرّد إنسان عادي، ولا حتى نبيّ عظيم بل هو ابن الله الحيّ .. ابن الله الوحيد بالحقّ والمحبّة. إن سُرور الآب السماوي هو معرفة البشر بالابن المبارك وتقديم العبادة الصحيحة له من خلال هذا الابن الوحيد العظيم. إذًا، «أنت بطرس» قال المسيح، «وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوي عليها» (١٦: ١٨). على صخرة الإيمان الواثق بالمسيح، والاعتراف الحسن، والفهم الصحيح لربوبيته ودلالة شخصه، يبني المسيحُ كنيسته وأبوابُ الجحيم لن تتمكّن من صد الهجوم السماويّ الذي تشنه الكنيسة، بغرض تخليص نفوس الناس من براثن الشرير ومن قبضة جحيمه. وها نحن نرى كلّ يوم، بل كُل ساعة، عشرات بل مئات الآلاف من البشر يأتون إلى المسيح معترفين بجلاله الإلهي، ونائلين في شخصه المعبود المبارك غُفرانًا لخطاياهم، وضمانًا لمصيرهم الأبديّ. هليلويا! شكرًا لله!
أخي الحبيب
أختي الغالية
إنَّ الكتاب المقدس يشهد للمسيح بأنه أكثرُ من مجرد نبيّ، فكل الأنبياء لا يمكنهم أن يُخلِّصوا شخصًا واحدًا من خطاياه. كل الأنبياء لا يمكنهم أن يغفروا ذنبًا واحدًا لآحاد الناس، بل أتجاسر فأقول إن الأنبياء أنفسهم بحاجة إلى من يشفع فيهم أمام عدالة الله، وإلى من يدفع عنهم ثمن خطاياهم ويغفرها لهم؛ إذ هم أيضًا ليسوا بمعصومين من الخطية ولا أبرياء منها. المسيح فقط .. المسيح وحده هو من يستطيع أن يغفر الخطية ويضمن الحياة الأبديّة .. له (أي للمسيح)، «يشهد جميعُ الأنبياء أن كلَّ من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا» (أعمال الرسل ١٠: ٤٣).
فهل تقبل من يده غفرانًا لخطاياك؟
افتح الآن قلبك له.
قل له «يا ربّ، إني أحتمي في محبتك وفداءك من دينونتك وغضبك الآتي». قل له «يا رب، إني أقبل من يدك الحياة الأبديّة التي يمنحها المسيح إذ دفع هو عني الثمن».
صلّ لله واطلب منه أن يغفر لك خطاياك .. إكرامًا للمسيح ابن الله الحيّ. آمين