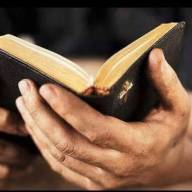مُقدّمة النّاشِر
بقلم القس أشرف بشاي
يَسُوع المَسيح!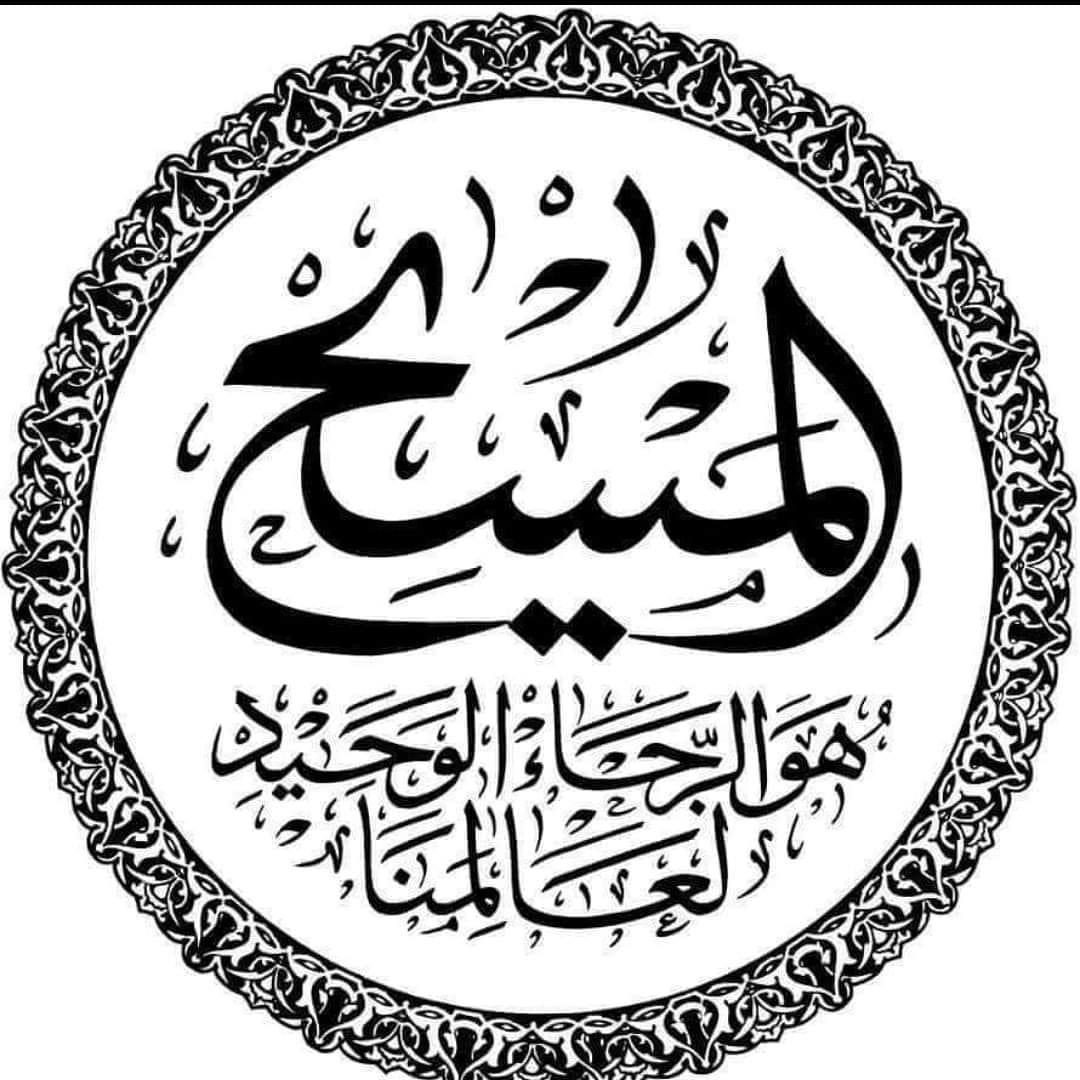
اسمٌ يكفي لكي يتوقّف كل إنسان مفكِّرًا ومتأمّلًا. قال البعض عنه إنّه «مُختل» (مَرقُس ٣: ٢١) واتهمه البعض الآخر بأنه «مُضل» (متّى ٢٧: ٦٣). احترمه الكثيرون ووضعوه بين مصاف المُعلّمين الصالحين كبُوذا وكُونفوشيوس وسُقراط، وقدّم له آخرون التوقير والتبجيل باعتباره نبيًا أو واحدًا من الأنبياء اليَهُود العظام؛ كإرميا أو يُوحنّا المعمدان (متّى ١٦: ١٤). وبخلاف كل أولئك وهؤلاء، يُصر المسيحيّون على أن المسيح «نسيجٌ وحده» لأنه مُتفرّد من كل الوجوه: لقد دخل إلى عالمنا بطريقة غير عادية إذ وُلد من عذراء بلا رجل، وعاش حياة غير عادية، إذ كانت حياته أكمل حياة يُمكن أن يعيشها إنسان على الأرض. شهد لطُهره وقداسته الأعداء قبل الأصدقاء.
صنع أقوى المعجزات: لمس الأبرص فطهُر، فتح أعين العميان، انتهر البحر فسكت، أشبع الآلاف بخمس خبزات من الشعير وسمكتيْن، وضع يده على النعوش فقام الموتى من بين الأموات. انجذب إليه الخطاة والفقراء والمرضى والضعفاء والزناة والمهمشّون، فوجدوا في علاقتهم به القيمة والمعنى لحياتهم. مات على الصليب ميتة المُجرمين وقُطّاع الطُرق، لكنه قام من بين الأموات تاركُا خلفه قبرًا فارغًا يشهد لبراءته مما نُسبَ إليه ظُلمًا. وأخيرًا ظهر لكثيرين من تلاميذه مُرسلًا إياهم ليتمّموا مسؤوليّتهم بين العالمين كالملح والنور. ادّعى المسيح ادعاءاتٍ مُذهلة لا يُمكن أن يُصدّقها العقل البشري، إذ قال عن نفسه إنه «الخبز الحيّ النازل من السماء»، «والطريق»، «والحق»، «والحياة»، «والقيامة»، «والراعي الصالح»، «والكائن» قبل الوجود في ذات جوهر الله.
فمن يكون المسيح إذًا؟
في هذا العصر الذي يُنادي فيه الكثيرون بـ «نسبيّة الحق»، وبأن كُل الطُرق تؤدي إلى رُوما وأن كل الديانات يُمكنها أن تقود الإنسان إلى الله، يجد المؤمنون بالمسيح صُعوبة في المناداة بالمسيح باعتباره «الطريق» بتعريف الألف واللام. ليس من السهل أن يتقبّل الإنسان الطبيعي أن المسيح هو «الطريق الوحيد» إلى الله، وأنه بدُون المسيح لن يجد المرء قبولًا أمام الله ولن يحصل على الحياة الأبدية التي يشتهيها كُل شخص أمين في بحثه عن «الطريق». إن «الإيمان بالمسيح وحده» يضرب غُرور الإنسان الطبيعي في مقتل!
أتذكر هنا قولًا شهيرًا لأحد الفلاسفة مفاده: «لو دخل فلانٌ إلى هذه القاعة التي نجتمع فيها الآن فلا بُد أن نقف جميعًا قدّامه احترامًا وإجلالًا، أما لو دخل المسيحُ علينا فلا بُد أن نجثو أمامه ساجدين!».
من هذا المنطلق، يقف هؤلاء الكُتّاب على أرض مُقدّسة، بنعالٍ مخلوعة، وهم يتكلّمون عن المسيح، ويدعون كل قارئ لكي يكتشف الأسباب الموضوعية التي دعتهم للقُبول بعقيدة «المسيح وحده» لضمان حياتنا وأبديتنا، مطمئنين إلى فهمهم الصحيح لكلمة الله المكتوبة؛ الكتاب المُقدّس، راجين أن يُقدَّم لهذا المصلوب المُقام ما يليق به من عبادة وإكرام وسُجود، لأنه «بَهَاءُ مَجْدِ الله، وَرَسْمُ جَوْهَرِهِ، وَحَامِلٌ كُلَّ الأَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ قُدْرَتِهِ، بَعْدَ مَا صَنَعَ بِنَفْسِهِ تَطْهِيرًا لِخَطَايَانَا، جَلَسَ فِي يَمِينِ الْعَظَمَةِ فِي الأَعَالِي» (العبرانيين ١: ٣-٤). ومهما كان الأمر، فإن المرء لا يُمكنه أبدًا أن يتجاهل المسيح؛ فموقفنا من المسيح يُحدِّد أبديتنا ومصيرنا النهائي، والتاريخ الإنساني لا يستطيع أن ينسى هذه التأثيرات الهائلة التي طبعتها حياة المسيح وموته وقيامته على البشريّة بأسرها. وحده يستحق كل المجد!