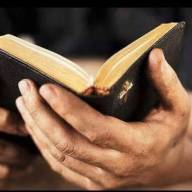كبرنا نحن العرب في بيئة ينتشر فيها شعرُ الفخر والهجاء. ما زلت أتذكّر قولَ شاعرٍ عربيّ قديم كان يفتخر قائلًا: ونشربُ إن وَرَدنا الماءَ صَفوًا ... ويشربُ غيرُنا كدرًا وطِينًا. وكبرنا، وبدأت أسئلتُنا تتغيّر مع نُضوج الفكر وتغيير التوجُّهات: لماذا لا نشربُ الماءَ صفوًا ثم نُعطي –أو حتى نسمح- لغيرنا أن يشربَ معنا من نفس الماء؟ لماذا نبني سعادَتنا على تعاسةِ الآخرين؟ لماذا نفتكر أنّ ما يتمتّع به الآخرون من بركات هو سَحْبٌ من رصيد البركات المحدود، وبالتالي نظن أنّه يتعيّن علينا أن نُصارِع حتى نتفوّق على الآخرين في نوال البركات؟ نتصوَّر أننا يجب أن نأخذ نحن قبل أن يأخذ الآخرون؟ إن الحياة تتّسعُ للجميع، والحرب والصراع لا يمكن أن يكونا قانونيْن للحياة!
ومن زاوية ثانية شربنا صغارًا شعرَ الهجاء الذي ينتقد الآخرين. واعتدنا سماعَ قصص الأنبياء الذين قتلوا وذبحوا، بل شقّوا أعداءهم حينما هجوْهم بالشعر! يُذكرّني ذلك الأمر دائمًا بلامك الشرير. كان لامك هذا هو أوّل من جمع بين زوجتيْن في التاريخ الكتابيّ. وكان أوَّل من شدا بشعر الفخر في الكتاب المقدَّس. وليس ذلك فحسب، بل إن ما شدا به لامك مُفتخِرًا كان القتل والانتقام! قال لامك لامرأتيه:
اسمعا قولي يا مرأتيّ لامك
وأصغيا لكلامي
فإنني قتلتُ رجُلاً لجرحي،
وفتىً لشدخي
إنّه يُنتقم لقايين سبعة أضعاف،
وأمّا للامك فسبعة وسبعين
في هذا المقال سوف نرى لمحة من تعاليم المسيح الذي اعتاد أن يُبهرَنا بكماله الأخلاقيّ وبتفرُّده في السُمو والقداسة. سوف نكتشف كيف كان المسيح يسبح دائمًا ضد التيار.
قال المسيح: «سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ: تُحِبُّ قَرِيبَكَ وَتُبْغِضُ عَدُوَّكَ. وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ، وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ، لِكَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِيكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، فَإِنَّهُ يُشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى الأَشْرَارِ وَالصَّالِحِينَ، وَيُمْطِرُ عَلَى الأَبْرَارِ وَالظَّالِمِينَ. لأَنَّهُ إِنْ أَحْبَبْتُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَكُمْ، فَأَيُّ أَجْرٍ لَكُمْ؟ أَلَيْسَ الْعَشَّارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ ذلِكَ؟ وَإِنْ سَلَّمْتُمْ عَلَى إِخْوَتِكُمْ فَقَطْ، فَأَيَّ فَضْل تَصْنَعُونَ؟ أَلَيْسَ الْعَشَّارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ هكَذَا؟ فَكُونُوا أَنْتُمْ كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ كَامِل» (متّى ٥: ٤٣- ٤٨).
لديّ بعض المُلاحظات السريعة حول هذا التعليم الذي قدّمه المسيح:
(١) إنّ المسيح في حديثه هذا لا يرفض كلمة الله الواردة في العهد القديم، بل بالعكس كان المسيح ينظر للعهد القديم نظرة احترام وتقدير وتوقير، فقد قال المسيح في بداية عظة الجبل: «لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ. فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلّ» (متّى ٥: ١٧-١٨). إن ما يرفضه المسيح ويُقاومه هنا هو التحريف الصارخ لكلمة الله، هذا التحريف الذي ارتكبه معلِّمو الشريعة اليهودية.
(٢) كان المسيح عالمًا بأنه من السهل على الإنسان أن يُخفِّف من حدّة وصيّة المحبّة طبقًا لأهوائه، كما فعل اليهود قديمًا. لكن محبّة الأعداء تقتضي منّا أن نتشوّق إلى توبتهم حتى يُؤمنوا فيخلصوا. علينا أن نصلي طالبين خلاصَ الأشرار الذين يُجدِّفون على الله، ويسيئون إلينا وإلى الآخرين. إن كُنا نؤمن أن نوالَ الخلاص وضمانَ الحياة الأبديّة في المسيح هو الخير الأسمى، فإنّ محبتَنا للجميع تقتضي منّا أن نُصلّي من أجل الجميع لنوال الخلاص.
(٣) إنّ محبتنا للجميع تسير على منوال محبّة الله الآب للجميع؛ فالله الذي يُشرق بشمسه على الأبرار والظالمين ويُمطر على الصالِحين والطالحين هو هو نفسُ الإله الذي سيُجازي المؤمنين وسيُعاقب الأشرار في اليوم الأخير. إن صلاحَ الله يعني –ضمن ما يعني- كراهيةَ الله للشر وللخطيّة. لذا فإنّنا نرى جُمهور المفديين يترنّمون شكرًا لله الذي لم يسكت في مُواجهة الشر والأشرار. إنهم يهتفون قائلين: «هليلويا، الخلاص والمجد، والكرامة والقدرة، للرب إلهنا، لأن أحكامه حقٌّ وعادلة .. آمين» (الرؤيا ١٩: ١-٤)، وبالتالي، فمحبتنا تقتضي تحذير الخطاة لأن يوم الدينونة آتٍ لا محالة.
(٤) ونظير أبينا السماويّ، لا يجب أن تكون كراهيتُنا للشر ملوَّثة بأي ضغينة شخصيّة، إذ المسيحي الحقيقي يعرف جيدًا أن يُميِّز بين الأشياء المكروهة والبشر الذين يصنعون هذه الأشياء.
(٥) إن المحبّة المسيحيّة للبشر ليست مُجرَّد إظهار للعواطف الطيّبة ولا التفوّه بكلمات حلوة، بل المحبّة الّتي يعلّمها الكتاب المقدَّس هي المحبة العمليّة «لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق» (١يوحنا ٣: ١٨). يتعيّن على المسيحي أن يعمل الخير للجميع –حتى للأعداء- فهكذا عاملنا الله «لأنّه ونحن بعد خُطاة مات المسيحُ لأجلنا» (رومية ٥: ١٠). قال أحدُ الملحدين ساخرًا: «ينبغي أن نسامح أعداءنا لكن بعد أن نشنقهم». أما المحبّة المسيحيّة فتطلب للجميع- بما فيهم الأعداء- الخير الأسمى والحياة الأبديّة.
(٦) وفي شرح «صلّوا لأجل الذين يُسيئون إليكم» يقول أحد اللاهوتيين: «إنها الوصيّة السامية، فمن خلال جوِّ الصلاة نذهب لعدوّنا، ونقف بجواره، ونتضرّع للرب من أجله». من المستحيل أن تصلي من أجل شخص دُون أن تحبّه، ومن المستحيل أن تستمرّ في الصلاة لأجل إنسان دون أن تكتشف أن محبتك له تزدهر وتزداد. وإن كانت عذابات المسيح القاسية لم تمنعه من رفع الصلوات والتشفُّع لأجل قاتليه فصلّى لهم قائلًا: «يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون» (لوقا ٢٣: ٣٤)، فأعتقد أنه لا يُوجد لدى المؤمنين بالمسيح أي مُبرِّر للامتناع عن الصلاة من أجل أعدائهم إن هم أرادوا التشبُّه بسيّدهم».
(٧) وأمام التضييق والاضطهاد الذي يُواجه مسيحيّي الشرق الأوسط، كثيرًا ما نجد أنفسنا غير قادِرين على الصلاة لأجل من يُظهرون العداوة لنا ويتمنّون لنا الفناء، بل ويعملون جاهدين في سبيل إيذائنا. أمام هذا الاضطهاد أقتبس مرّة ثانية من أحد لاهوتيّي القرن التاسع عشر، وكأنّه كان يتنبّأ عن الأيام القاسية التي يجتاز فيها مسيحيّو الشرق الأوسط نيرانَ التجارب والآلام، فقال: «إنّ وصيّة أن نحبّ أعداءَنا، وأن نصفح عنهم، وأن نُحسن إليهم صارت وصيّة مُلحّة هذه الأيام. إنّ المُؤمنين سيُطارَدون من مكان إلى مكان، وسيُمثَّل بهم، وسيُعذَّبون، وسيُقتلون بعد أنواع من التعذيب. نحن نقترب من عصر الاضطهاد الواسِع الانتشار. وسيأتي سريعًا الوقتُ الذي سنصلّي فيه صلاةَ محبّةٍ عميقة لأجل أعدائنا وأبناء الهلاك المُلتفين حولنا، ولأجل الذين ينظرون إلينا نظرات الكراهيّة. إنّ الكنيسة التي تنتظر الربَّ حقّا والتي تُميِّز علاماتِ الأزمنة ينبغي لها أن تعيش حياةً مقدَّسة وأن تتسلَّح بصلاة المحبّة».
(٨) ربَّما يقول قائل: «ولكن يُعاب تلك التعاليم السامية أنّها تعاليم مستحيلة التطبيق والتنفيذ، هل فعلًا يمكن للإنسان أن يحبَّ عدوَّه بل ويطلب له الخير؟! أعترفُ أن هذا السؤال بارعٌ جدًا: من المستحيل على الإنسان العاديّ أن يُنفِّذ وصيّة كهذه بدُون نعمة كافية من الله. فإن كُنّا نحبّ الذين يُحبِّونَنا فقط فلسنا أفضل من الأشرار، وأن كُنّا نُسلِّم على إخوتنا فقط فلسنا أفضل من الوثنيّين؛ فالوثنيّون أيضًا يُسلِّمون على بعضهم البعض. إنّ المسيح يتساءل والحال هذه: «أي فضل تصنعون؟» ما الشيء غير العاديّ في محبّة من يُحبّوننا؟ ليس كافيًا أن يُشبه الإنسانُ المؤمن غيرَ المؤمنين، فدعوة المؤمنين هي إلى التميُّز في الفضائل، لأنّ المسيح الذي أحبّنا ومات لأجلنا «فائق فوق الكل». لقد أحبّنا الله ونحن في حال البُعد والعصيان والعداوة. ولقد مات المسيح لأجلنا على الصليب ونحن أعداء «لأنّه ونحن بعد خُطاة مات المسيح لأجلنا .. ونحن أعداء قد صُولحنا مع الله بموت ابنه»، فما دام الصليب هو شِعار المسيحيّة المرفوع أمام الجميع، فنحن المسيحيّين مدعوون للتشبُّه بسيدنا المسيح.
(٩) محبّة المسيحيين لأعدائهم هي ثمر عمل الله في قلوبهم بالروح القدس؛ فالطبيعة الجديدة التي يتحصّل عليها المؤمنون تخلق فيهم جُوعًا شديدًا وعطشًا دائمًا لحياة البر والقداسة والأمانة والمحبّة. إن نوعيّة حياتنا ستُظهر انتماءَاتِنا السماويّة. لقد تغيّرت بوصلةُ انتمائنا، فصرنا لا نتشبّه بالعالم بل بالآب السماوي، فأصبحت نوعيّةُ القيّم التي تحكم حياتنا مُختلفةً ومتميّزة.
صديقي،
هل ترى أن هذا الكلام صعب؟ وأنا كذلك أراه صعبًا بل مستحيلاً. فكما قلتُ من قبل: من المستحيل على الإنسان العاديّ أن يتمكّن من تنفيذ وصيّة كهذه، لكن مُنذ متى كانت المسيحيّة تُساير ما هو سائد بين البشر من قيمٍ ومبادئ؟ منذ متى كان المسيح واحدًا من البشر أو الأنبياء العاديّين؟ منذ متى كانت تعاليم المسيح كغيرها من التعاليم؟ نعم. ما يطلبه المسيحُ منّا صعب، لكن لم يكن المسيح يأمر أتباعَه بشيء حيثُ لا تستطيع نعمتُه أن تُعينهم من أجل تنفيذ الوصية الصعبّة أو المُستحيلة؛ فشكرًا لمن لم يأمرنا فقط، بل أيضًا يُعينُنا على السير في طريق طاعته وحِفظ وصيته