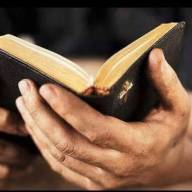كثيرًا ما يكون الإنسان قريبًا جدًا من تحقيق الهدف الذي ناضل طويلًا من أجله، لكنه بالأسف يُخفق في آخر ثانية. كثيرًا ما يكون المرءُ على وشك بُلوغ الغاية التي سعى إليها باجتهاد، لكنه بفشل في آخر لحظة! ينطبق ذلك على اللاعب الذي يركل الكرة فتصيب القائم، وعلى الطالب الذي يُحرم من دخول الكلية التي يتمنّاها بسبب رُبع أو نصف درجة، وعلى المسافر الذي تفوته الطائرة بسبب تأخره لبضعِ ثوانِ بعد إغلاق بوّابة الإقلاع .. وهلم جرّا ..وما أكثر الأمثلة على الخسارة الّتي تحدث بسبب هفوة بسيطة أو ثانية زمنيّة من التأخير، أو بسبب آخر يكاد لا يكون مرئيًا بالعين المُجردّة!
وفي إحدى مقابلات المسيح مع أحد الرجال اليهود، سأل المسيحُ سؤالاً للرجل فأجاب الرجل بعقل وحكمة، فقال له المسيح: «لستَ بعيدًا عن ملكوت الله» (مرقس ١٢: ٢٤). كان الرجل قريبًا جدًا من حافة الملكوت، لكن الإنجيل لا يُخبرنا ما إذا كان الرجل قد نال هذه النعمة أم لا!
في مقالنا هذا نقرأ عن رجل آخر كان قريبًا جدًا من المسيح، لكنه لم ينتهز الفُرصة الغالية فضاعت منه إلى الأبد، ولم يبق له إلا الخسارة والندم! نقرأ هذه الحادثة في بشارة مرقس الأصحاح العاشر الآيات ١٧: ٢٢.
«وَفِيمَا هُوَ خَارِجٌ إِلَى الطَّرِيقِ، رَكَضَ وَاحِدٌ وَجَثَا لَهُ وَسَأَلَهُ: «أَيُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ، مَاذَا أَعْمَلُ لأَرِثَ الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ؟» فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ. أَنْتَ تَعْرِفُ الْوَصَايَا: لاَ تَزْنِ. لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ. لاَ تَسْلُبْ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ». فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ: «يَا مُعَلِّمُ، هذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي». فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحَبَّهُ، وَقَالَ لَهُ: «يُعْوِزُكَ شَيْءٌ وَاحِدٌ: اِذْهَبْ بِعْ كُلَّ مَا لَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ، فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَعْنِي حَامِلًا الصَّلِيبَ». فَاغْتَمَّ عَلَى الْقَوْلِ وَمَضَى حَزِينًا، لأَنَّهُ كَانَ ذَا أَمْوَال كَثِيرَة».
لقد جاء هذا الشاب الغنيُّ إلى المسيح جاثيًا. ويحمل هذا التصرُّف من الدلائل والمعاني الكثيرَ والكثير. مُنتهى الاحترام الفائق. منتهى الشجاعة في الاعتراف بمقام ومكانة هذا المعلّم الفقير، الذي لم تعترف به يومًا المؤسساتُ الدينية الرسمية. مُنتهى الرغبة الصادقة والنبيلة في تبعيّة هذا المعلِّم الجليل «جاء الشاب راكضًا». ومُنتهى الصدق في مُحاولة الوصول إلى الكمال الأخلاقيّ والدينيّ. يا له من شاب جديرٍ بالاحترام وجديرٍ بالحُب!
وبرغم نُبل المقصد وروعة الهدف إلا أنّ هذا الشاب ارتكب ثلاثةَ أخطاءٍ قاتلة:
(١) لقد سأل سُؤالاً خاطئًا.
(٢) لقد اعتقد في نفسِه اعتقادًا خاطئًا.
(٣) وآخر الأخطاء وأكثرها دمارًا: لقد اتخذ قرارًا خاطئًا.
سأل سؤالًا خاطئًا: سأل هذا الشاب المسيح قائلًا: «ماذا أعمل لأرث الحياة الأبديّة» (١٧). يحمل هذا السؤال إخلاصًا ظاهريًا كبيرًا؛ فما أمجد أن يسعى الإنسان في سبيل نوال الحياة الأبديّة. وهل هناك غاية أجمل من هذه الغاية؟ هل هناك هدف أكثر ديمومة من الحياة الأبديّة؟ إن الحياة الأبديّة هي الحياة بالحقيقة، وهي أبديّة بمعنى أنها لا تنتهي، لأن كلمة أبديّ معناها «مثل الله». حياة خالدة لا تنتهي. لكن روعة السؤال وأهميته لا تعني صِحّتَه! لقد سأل الرجلُ المسيح: «ماذا أعمل لأرث الحياة الأبديّة؟» وكأن الحياة الأبديّة يمكن أن تُنال بالعمل الصالح. وما زال الكثيرون حتى اليوم يسألون نفس السؤال الخاطئ، ويتلقّون من المسيح نفس الإجابة!
بماذا أجاب المسيح الشاب؟ قال المسيح بداية: «لماذا تدعوني صالحًا؟ ليس أحدٌ صالح إلا واحدٌ وهو الله!». وقد يرى البعض أن هذه الآية تنفي عن المسيح صفةَ الألوهيّة الواضحة لكلّ من يقرأ الكتاب المقدس، دُون أن يدروا أن المسيح كان يُخاطب إنسانًا لم يرَ في المسيح إلا «معلّمًا صالحًا». كان جوابُ المسيح يحمل معنىً ضمنيًا مفادُه «ما دمتَ لا ترى فيّ إلا مُعلّمًا فقط، ما دُمتَ تدعونني معلّمًا وحسْب، فلا معنى لإسباغ صفةَ الصلاح عليّ؛ فالصلاح لله وحده، وكلّ البشر-بما فيهم المعلِّمون- خطاةٌ ومذنبون».
ثم أجاب المسيح على سُؤال الشاب الغني بطريقة حكيمة، كانت كفيلة بلمس أوتار قلبه. قال له المسيح: «افعل الوصايا: لا تقتل، لا تزن، لا تسلب (أو لا تظلم)، أكرم أباكَ وأمّك». وكأنّي بالمسيح يقول له: «ما دمتَ تتخذَ من الأعمال الصالحة سبيلًا لنوال الحياة، إذًا هيّا: أمامك المجالُ مفتوحًا لتثبتَ جدارتَك! هيّا رِث الحياة الأبديّة لو تمكّنت من طاعة كلّ وصايا الله طاعة كاملة!»
بعيدًا عمّا يُقرِّره ويُؤكِّده الكتاب المقدَّس، ألا تؤكِّد خبراتُنا الإنسانية الفشلَ الكامل لكلّ البشر في هذا المجال؟ هل تمكّن شخصٌ واحد؛ شخصٌ واحد فقط من طاعةِ الله بالتمام طيلة العُمر؟ إنّ البشر خطاؤون وخيرُ الخطّائين المُحتمون في برّ المسيح. لن يستطيع الإنسان مهما أوتيّ من حكمة واستبصار وإخلاص أن يطيعَ الله طاعةً دائمة كاملة. وما دُمنا نسقط في الخطية فلا نوال للحياة الأبديّة، لأن الله القُدوس والإنسان الخاطئ لا يجتمعان.
وأكثر من ذلك لقد اعتقد الرجل عن نفسه اعتقادًا خاطئًا. أجاب الرجلُ قائلًا: «هذه كلُّها –أي كل هذه الوصايا- حفظتها منذ حداثتي» (٢٠). ورغم إعجابي بهذه الجرأة إلا أنها جُرأة في غير محلها: مَن من البشر يستطيع أن يدّعي هذا الادعاء؟ «هذه كلها حفظتها منذ صباي»: ألم تخطئ أيُّها الشاب ذات مرّة؟ ألم يغويك حماسُ الشباب وقُوّة الصبا؟ ألم يهمس الشيطانُ همساتِه الشريرة في أذنك فأطعت؟ ألم تُحاوطك الإغراءات فهويت؟ ألم تغفل ولو مرّة واحدة فسقطت؟!
إنّني على يقين أنّ هذه الإجابة تُجافي الحقيقة تمامًا؛ فالبشر –كلّ البشر- شربوا من ذات الكأس الشريرة، وقطفوا من نفس الشجرة اللعينة، ومنذ أن سقط أبوانا الأوّلان؛ آدم وحواء، ونحن على ذات درب الخطيّة والشر نسير. كلُّنا بلا استثناء .. كلُّنا مرضى خُطاةٌ ليس فينا أبرياء!
نظر المسيح إلى هذا الشاب متفرسًا. ويُدّون لنا البشير مرقس هذا التعبير الغريب: «وأحبّه». لقد أحبّ يسوع هذا الشاب. ربّما كان هذا الحب بسبب إخلاص السُؤال، أو بسبب رغبة البحث عن الكمال الأخلاقيّ، أو لعلّه أحبّه بسبب حماسة الرغبة في اتّباع المسيح .. مهما يكن الأمر، فقد كان هذا اللقاء بالنسبة لهذا الشاب هو الفُرصة الذهبيّة لنوال الحياة الأبديّة، لكنه بالأسف لم ينتفع بتلك الفرصة الثمينة.
أسوأ الكلّ: لقد اتّخذ هذا الشاب قرارًا خاطئًا، بل أسوأ وأغبى قرار يمكن أن يتخذه إنسانٌ في حياته. لقد رفض توصية المسيح «يُعْوِزُكَ شَيْءٌ وَاحِدٌ: اِذْهَبْ بِعْ كُلَّ مَا لَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ، فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَعْنِي حَامِلًا الصَّلِيبَ». لذا فإنّ القدم التي رفضت أن تتبع المسيح جرّت صاحبَها إلى الهلاك، والقلبَ الذي استثقل طاعةَ المسيح قاده عصيانُه إلى الضياع! حينما سمع الشاب الغني هذا الأمر الإلهيّ، يقول البشير إنه «اغتّم على القول»، وهذا التعبير يُقصد به أن وجهَه قد أصابه الشُحوب وتغيّر لونُه، لأنه لم يكن مُتوقعًا أن يأمره المسيح بهذا الأمر!
لكن الأسوأ من تغيُّر لون الوجه هو القرار الذي اتّخذه هذا الشاب. لقد «مضى حزينًا» إذ تيقن أن المسيح كشف أعماقَ قلبه وعرف مكنوناته. لم تكن تقواه أصيلةً ولم تكن طاعتُه للوصايا حقيقيّة: غالبًا كان هذا الشاب يحتمي بأموالِه الكثيرة ويستخدمُها في خلق بيئةٍ مثالية، قدرَ استطاعتِه، ليمارسَ الصلاحَ داخل حدود هذه البيئة. لذا فإنّ التضحية بالأموال كانت تعني فُقدان القُدرة على مُمارسة الصلاح الظاهري أمام الناس.
لقد استثمر المسيحُ الفرصةَ ليُقدِّم لتلاميذه تعليمًا عن المال وعن محبة المال. إنّ المال متى صار سيّدًا للإنسان يصبح حائطًا يفصلُنا عن ملكوت الله، لكنه يمكن أن يكون عطيّة من عطايا الله الصالحة متى كان المؤمن وكيلًا أمينًا عليه. يمكن للمال أن يكون إلهًا قاسيًا، ومن المُمكن أن يصير عبدًا مُطيعًا نافعًا. المُهم في مسألة المال هو المكانة التي يحتلها في قلب الإنسان. قال المسيح: «لاَ تَكْنِزُوا لَكُمْ كُنُوزًا عَلَى الأَرْضِ حَيْثُ يُفْسِدُ السُّوسُ وَالصَّدَأُ، وَحَيْثُ يَنْقُبُ السَّارِقُونَ وَيَسْرِقُونَ. بَلِ اكْنِزُوا لَكُمْ كُنُوزًا فِي السَّمَاءِ، حَيْثُ لاَ يُفْسِدُ سُوسٌ وَلاَ صَدَأٌ، وَحَيْثُ لاَ يَنْقُبُ سَارِقُونَ وَلاَ يَسْرِقُونَ، لأَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكَ أَيْضًا. .. لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ، لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْغِضَ الْوَاحِدَ وَيُحِبَّ الآخَرَ، أَوْ يُلاَزِمَ الْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ الآخَرَ. لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا اللهَ وَالْمَال» (متّى ٦: ١١- ٢٤). والسؤال هو: أيّ الإلهيْن نعبد؟ متى فتح الإنسانُ قلبَه لله فإنّ كنوزَ الأرض لن تعود تُغنيه، وأموالَ الدنيا لن يكون لها قِيمة، إلا بقدر ما تخدمه هذه الأموال في خِدمة ملكوت الله. قال أحدُ المصلحين مرّة: «إن آخر شيء يتجدّد في الإنسان المؤمن هو جيبه!»
صديقي، ليتك تترك محبّةَ المال جانبًا، لتعبد ذاك الذي أعطانا القُدرة لاصطناع الثروة. لا تدع محبّة المال تقودك إلى الهلاك، بل تعال لتكون أنت وما لك في شرف خِدمة ملكوته. له كلُّ المجد.