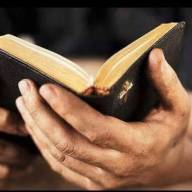ما أكثر الضعفات التي تظهر في حياة البشر، فالإنسان أمام المعاصي ضعيف ولا طاقة له بمُقاومة الخطايا والآثام. حتى أفضل البشر اعترفوا آسفين بضعفِهم أمام الخطية: قال داود: «هانذا بالإثم صُورتُ وبالخطيّة حبلت بي أمي» (المزمور ٥١: ٥)، وعندما اختبر حلاوةَ الغفران هتف قائلًا: «طوبى للرجل الذي غُفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الربُّ خطية» (المزمور ٣٢: ١-٢). ونبيّ الله إشعياء فقد أطلقها حقيقةً صريحة: «كلنا كغنم ضللنا، ملنا كُلُّ واحد إلى طريقه» (إشعياء ٥٣: ٦). أما سليمان الذي كان أحكم البشر في جيله فقد قال إنّ «كُل إنسان يعرف ضربَةَ قلبِه» (١الملوك ٨: ٣٨). تنطبق هذه الحقيقة إذًا على الجميع، على الملك والمملوك، على الغنيّ والفقير، على الأمير والغفير، على الأشيب والطفل. ونقول في أمثالنا العاميّة إنّ الإنسان خاطئ ولو كان في الحياة ابنَ يومٍ واحد!
لكن هذا الإنسان الخاطئ حاول باستمرار أن يرضي الله. ولأجل هذا خلق الإنسانُ الدياناتِ. في كل ديانات العالم، يُحاول الإنسان أن يُرضي الله، يُحاول أن يجد وسيلة للوصول إلى هذا الإله، لمعرفة شخصه والتجاوب من مُتطلبات برّه وقداسته. يرفع الصلوات، ويُقدّم القرابين والتقدمات، ويُحاول اكتشاف ما يسرّ الله أو يجلب له الرضى. أمّا في المسيحيّة، فيقدِّم الكتاب المقدَّس أطروحة مُغايرة بالتمام. إن الله في المسيحيّة هو من قام بالفعل بمُصالحة الإنسان لنفسه. لم تكن عملية المُصالحة هذه أمرًا سهلًا، بل لقد تكلّفت أغلى الأثمان. لقد دفع الله ثمن خطيّة الإنسان في شخص ابنه؛ الرب يسوع المسيح؛ حملِ الله الذي يرفع خطيّة العالم (يوحنا ١: ٢٩). الذبيح العظيم الذي يكافئ، بل يتفوّق، على كل البشر بما لا يُقاس لكونَه الله الظاهر في الجسد. لأجل هذا كانت الكنيسة الأولى تُرنِّم: «وبالإجماع عظيمٌ هو سرُّ التقوى: الله ظهر في الجسد، تبرَّر في الروح، تراءى لملائكة، كُرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رُفع في المجد» (١تيموثاوس ٣: ١٦).
عن عمل الله في المسيح المصلوب المقام يكتب الرسول بولس قائلاً:
«لأَنَّ الْمَسِيحَ، إِذْ كُنَّا بَعْدُ ضُعَفَاءَ، مَاتَ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ لأَجْلِ الْفُجَّارِ. فَإِنَّهُ بِالْجَهْدِ يَمُوتُ أَحَدٌ لأَجْلِ بَارّ. رُبَّمَا لأَجْلِ الصَّالِحِ يَجْسُرُ أَحَدٌ أَيْضًا أَنْ يَمُوتَ. وَلكِنَّ اللهَ بَيَّنَ مَحَبَّتَهُ لَنَا، لأَنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسِيحُ لأَجْلِنَا. فَبِالأَوْلَى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُتَبَرِّرُونَ الآنَ بِدَمِهِ نَخْلُصُ بِهِ مِنَ الْغَضَبِ! لأَنَّهُ إِنْ كُنَّا وَنَحْنُ أَعْدَاءٌ قَدْ صُولِحْنَا مَعَ اللهِ بِمَوْتِ ابْنِهِ، فَبِالأَوْلَى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُصَالَحُونَ نَخْلُصُ بِحَيَاتِهِ! وَلَيْسَ ذلِكَ فَقَطْ، بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا بِاللهِ، بِرَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي نِلْنَا بِهِ الآنَ الْمُصَالَحَة» (رسالة رومية ٥: ٦- ١١).
دعني أيها القارئ الحبيب ألخّص لك حديثي إليك اليوم:
- حالتنا قبل أن يدركنا المسيح.
- ما الذي أنجزه المسيحُ لأجلنا.
- حاضرُنا ومستقبلنا كمؤمنين بالمسيح.
أولًا، حالتنا قبل أن يدركنا المسيح:
يُقدِّم لنا الوحي المبارك حالتنا ونحن في الخطيّة، في أوصاف أربعة: ضُعفاء، فُجّار، خُطاة، أعداء. والشخص الضعيف هو الشخص غير القادر على تخليص نفسه. أقرب صورة إيضاحيّة لهذا الشخص الضعيف هي صورة اليهوديّ الذي تحدّث عنه المسيح في مثل السامري الصالح. كان هذا اليهودي قد وقع بين اللصوص فعرّوه، وجرّحوه ومضوا وتركوه بين حيّ وميت. كان مصير هذا المسكين هو الموت المحقّق لا محالة، لولا أن عناية الله قد دبَّرت له هذا شخصًا من السامرة الذي أشفق عليه وأنقذه. أما الشخص الفاجر فهو الإنسان الذي يتخطّى الحدود الإلهيّة كاسرًا الوصية ومرتكبًا للخطيّة التي نهانا الله عنها. والشخص الخاطئ هو الشخص الذي يفعل عامدًا الذنوب التي لا يجب أن يرتكبها الإنسان. أخيرًا، فالشخص العدو فهو الشخص الذي وضع نفسه في موضع العداوة مع الله نتيجة لخطاياه وآثامه. إن الله لا يُعادي البشر، بل هو لا يُعادي بالمرّة. المشكلة أن الإنسان هو الذي اختار أن يُخاصم الله بفعل الشر، وارتكاب المعاصي، وبكسر القانون الأخلاقي الذي وضعه الله، باعتباره الحاكم الأعلى لهذا الكون! يا لها من ورطة وقع فيها كل البشر!
ثانيًا، الخلاص الذي قدّمه المسيح:
بكلمات صريحة وقاطعة ولا تقبل الجدل، يقول الوحي على لسان الرسول بولس إن «المسيح مات لأجلنا». صحيح أن «أجرة الخطية هي موت» (رومية ٦: ٢٣). وفي كل الكتاب المقدّس ترتبط الخطيّة مع الموت ارتباط السبب بالنتيجة. وفي كل الكتاب المقدس تصدق هذه القاعدة صدقًا كاملاً، الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو في حادثة صلب المسيح؛ تاريخيّا مات المسيح بلا ذنب أو جريرة: كيف لا، وهو القدوس الذي شهد له تلاميذه بولس وبطرس ويوحنا قائلين إنه لم يفعل خطيّة (٢كورنثوس ٥: ٢١)، ولم يعرف خطيّة ولا وُجد في فمه غش (١بطرس ٢: ٢٢)، وليس فيه خطيّة (١يوحنا ٣: ٦). وليس فقط هو قدوس بشهادة تلاميذه الأطهار، بل أيضًا بشهادة الأعداء الذين شهدوا لكماله المطلق. ألم يقل فيه قائد المئة الذي أشرف على عملية صلبه: «بالحقيقة كان هذا الإنسان بارًا» (لوقا ٢٣: ٤٧). ألم يتحدَّ المسيحُ أعداءه قائلًا: «من منكم يبكّتني على خطيّة» (يوحنا ٨: ٤٦)؟ إنّه القدوس البار .. إنّه القدوس وحده.
لماذا إذًا مات المسيح إن كانت الخطيّة ترتبط بالموت ارتباط السبب بالنتيجة؟ لقد مات المسيح لأنّه قبل أن يكون بديلًا عنّا. قَبِل المسيح أن يموت لأجل خطايانا. قبل ذلك طوعًا لا كرهَا. قبل المسيح هذا الموت لأجل خلاصنا نحن البشر. لقد قال المسيحُ لتلاميذه يومًا: «وَلِي خِرَافٌ أُخَرُ لَيْسَتْ مِنْ هذِهِ الْحَظِيرَةِ، يَنْبَغِي أَنْ آتِيَ بِتِلْكَ أَيْضًا فَتَسْمَعُ صَوْتِي، وَتَكُونُ رَعِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَرَاعٍ وَاحِدٌ. لِهذَا يُحِبُّنِي الآبُ، لأَنِّي أَضَعُ نَفْسِي لآخُذَهَا أَيْضًا. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْخُذُهَا مِنِّي، بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِي. لِي سُلْطَانٌ أَنْ أَضَعَهَا وَلِي سُلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَا أَيْضًا. هذِهِ الْوَصِيَّةُ قَبِلْتُهَا مِنْ أَبِي» (يوحنا ١٠: ١٦- ١٨). وعندما وقف أمام بيلاطس أثناء محاكمته وصلبه قال له: «لم يكن لك عليّ سلطانٌ البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق» (يوحنا ١٩: ١١). لقد مات المسيح لأجل خطايانا نحن، لا من أجل خطيته هو. ما أصدق ما قاله الواعظ الإنجليزي الشهير تشارلز سبرجن. قال: «إنّ إيماني بالمسيح يتلخّص في كلمات ثلاث: «المسيح مات لأجلي»».
اسمح لي أن أسألك: هل تقبل بشكر وسرور العملَ الذي صنعه الله في المسيح فاديًا؟ هل تقبل موت المسيح من أجلك؟ هل تترك برَّك الزائف واعتمادك على أعمالك الصالحة التي لن تنفعك بشيء في اليوم الأخير؟ ليتك تلتفت إلى المسيح المُخلّص فتخلص وتحيا!
ثالثًا، حاضرنا ومستقبلنا كمؤمنين في المسيح:
- نحن الآن مصالحون مع الله: لقد انتقلنا من موقع العداوة إلى خانة المصالحة. هليلويا. ما أعظم عمل الله لأجلنا. لم نعد نخشى دينونة الله لنا لأنه: «لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع» (رومية ٨: ١). لقد تغيّرت طبيعتُنا الشريرة وصارت طبيعة سماوية مقدّسة: نحبُّ البر، ونكره الشر. صرنا نصلي من أجل الأشرار حتى تفتقدهم نعمةُ الله. صار لنا رجاءٌ أبدي بالمسيح يسوع ربنا لن يخيب. لقد صار خوفنا –إن كان ثمّة خوف- ليس من الموت، بل من الحياة الحاضرة. إن الموت هو بوّابةُ عُبورِنا الذهبية إلى الله، الله الذي صالحنا لنفسه بالمسيح يسوع. أما الحياة الحاضرة فهي الفرصة الوحيدة التي يجب أن نستثمرها في خدمة الله والناس، فإن ضاعت كانت خسارتنا كبيرة، لكونها فرصتنا الوحيدة لإكرام الله وتمجيده. لذا، فالمسيحي الحقيقي لا يهابُ الموت بل يحرص على الحياة لمجده. إن ترنيمته: «لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح» (فيلبي ١: ٢١).
- لنا شفاعتُه المباركة التي ستظل ترافقنا، وتضمن حمايتَنا، وترثي لضعفاتنا، وتؤازر جهادَنا حتى نصل إلى بيتنا الأبدي بسلام. يقول الرسول: «لأَنَّهُ إِنْ كُنَّا وَنَحْنُ أَعْدَاءٌ قَدْ صُولِحْنَا مَعَ اللهِ بِمَوْتِ ابْنِهِ، فَبِالأَوْلَى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُصَالَحُونَ نَخْلُصُ بِحَيَاتِهِ!» (رومية ٥: ١٠). إنّ قيامة المسيح من الموت، وصعوده الظافر، وامتلاكه العرش الرفيع عن يمين عظمة الآب، كل هذه قد جعلت من المسيحَ شفيعَ مومنيه الأوحد. لذا فإن كان موتُه لأجلنا قد خلّصنا من خطايانا السالفة فإنّ حياته الآن في السماء وشفاعته المجيدة لأجلنا هُمّا الضامن العظيم لنجاح رحلتنا وسلامة إيماننا على الأرض. شكرًا لله: لنا في موت المسيح وحياته الحاضرة غُفرانًا لماضينا، ورفقة لحاضرنا، وضمانًا لمستقبلنا. هليلويا .. شكرًا لاسمه العظيم.
أخيرًا، أود أن أضع أمامك كلمات الوحيّ لتتأمّل فيها: «فَإِذْ لَنَا رَئِيسُ كَهَنَةٍ عَظِيمٌ قَدِ اجْتَازَ السَّمَاوَاتِ، يَسُوعُ ابْنُ اللهِ، فَلْنَتَمَسَّكْ بِالإِقْرَارِ. لأَنْ لَيْسَ لَنَا رَئِيسُ كَهَنَةٍ غَيْرُ قَادِرٍ أَنْ يَرْثِيَ لِضَعَفَاتِنَا، بَلْ مُجَرَّبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُنَا، بِلاَ خَطِيَّةٍ. فَلْنَتَقَدَّمْ بِثِقَةٍ إِلَى عَرْشِ النِّعْمَةِ لِكَيْ نَنَالَ رَحْمَةً وَنَجِدَ نِعْمَةً عَوْنًا فِي حِينِه» (العبرانيين ٤: ١٤- ١٦).