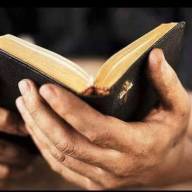بقلم القس أشرف بشاي

أمران تكرههما كُلّ زوجة: الغيرة المُبالغ فيها والشك. إنّ الشك تعبير عن عدم الثقة في شخص المحبوب. ينطبق ذلك على كل العلاقات البشريّة أمّا في علاقتنا مع الله فالأمر يختلف قليلًا: يريد الله أن تنبني علاقتُنا معه على الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو «الثقة بما يُرجى والإيقان بأمور لا تُرى» (عبرانيين١١: ١). نحن نؤمن بالشمس حتى ولو غابت، ونصدِّق أن الطائرة ستصل بنا إلى وجهتنا رغم عدم معرفتنا الشخصيّة بقائدها، ونثق في أطبائنا رغم أنّنا لم نكن معهم حين درسوا الطب أو الجراحة. إنّ الإيمان ليس رفاهية ولا أمرًا زائدًا عن الحاجة، بل هو ضرورة أساسيّة من ضرورات العلاقات الناجحة. وفي علاقتنا مع الله يُطالبنا الله بالإيمان به والثقة فيه وهو يُكافئ هذا الإيمان ويُقدِّره.
سأروي هنا حادثة شك يُوحَنَّا المعمدان في شخص المسيح. لقد أُخبر يُوحَنَّا المعمدان بالمعجزات العظيمة التي صنعها المسيح حين شفى المرضى وأقام الموتى. عندئذ «دَعَا يُوحَنَّا اثْنَيْنِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ، وَأَرْسَلَ إِلَى يَسُوعَ قَائِلاً: «أَنْتَ هُوَ الآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ؟» فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهِ الرَّجُلاَنِ قَالاَ: «يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ قَدْ أَرْسَلَنَا إِلَيْكَ قَائِلاً: أَنْتَ هُوَ الآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ؟» وَفِي تِلْكَ السَّاعَةِ شَفَى كَثِيرِينَ مِنْ أَمْرَاضٍ وَأَدْوَاءٍ وَأَرْوَاحٍ شِرِّيرَةٍ، وَوَهَبَ الْبَصَرَ لِعُمْيَانٍ كَثِيرِينَ. فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُماَ: «اذْهَبَا وَأَخْبِرَا يُوحَنَّا بِمَا رَأَيْتُمَا وَسَمِعْتُمَا: إِنَّ الْعُمْيَ يُبْصِرُونَ، وَالْعُرْجَ يَمْشُونَ، وَالْبُرْصَ يُطَهَّرُونَ، وَالصُّمَّ يَسْمَعُونَ، وَالْمَوْتَى يَقُومُونَ، وَالْمَسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ. وَطُوبَى لِمَنْ لاَ يَعْثُرُ فِيَّ» (لوقا ٧: ١٩-٢٣).
كان الملكُ هيرودس قد أصدر أمرًا باعتقال يُوحَنَّا المعمدان لأنّ المعمدان كان قد وبّخ الملك الذي أخذ زوجةَ أخيه على حياة أخيه. غضب الملك فسجن يُوحَنَّا، وطالت مدة الاعتقال حتى زادت عن سنة، إلا أنّ تلاميذ يُوحَنَّا المعمدان كان مسموحًا لهم برُؤية معلِّمهم فأخبروه بمعجزات المسيح العجيبة: لقد شفى المسيح عبدَ قائد المئة الرّوماني بمُجرّد الكلمة وعن بُعد، بل لقد أقام المسيحُ الشاب الميت؛ ابن أرملة نايين. أخبر التلاميذُ معلِّمَهم كيف تتبع الجماهير العريضة المسيح، وكيف تذهلُهم تعاليمه الساحرة وتدهشُهم أفعاله الباهرة.
كان ليوحنا المعمدان علاقة حلوة وعميقة مع المسيح. لقد عرف المعمدان قدرَ المسيح، وأحبّه حُبًّا جمًا. ويوحنا –بدوره- لا يرتاب أبدًا في حب المسيح له. فكيف لا يسأل المسيح عن المعمدان في سِجنه هذه الأشهر الطويلة؟ بل كيف لا يتدخّل المسيح مُعجزيًا لإنقاذه وإنصافه؟ أليس المسيحُ نصيرَ المظلومين؟ أليس هو مسيا الله «حبيبي الَّذِي أَعْضُدُهُ –يقول الآب- مُخْتَارِي الَّذِي سُرَّتْ بِهِ نَفْسِي. وَضَعْتُ رُوحِي عَلَيْهِ فَيُخْرِجُ الْحَقَّ لِلأُمَمِ. لاَ يَصِيحُ وَلاَ يَرْفَعُ وَلاَ يُسْمِعُ فِي الشَّارِعِ صَوْتَهُ. قَصَبَةً مَرْضُوضَةً لاَ يَقْصِفُ، وَفَتِيلَةً خَامِدَةً لاَ يُطْفِئُ. إِلَى الأَمَانِ يُخْرِجُ الْحَقَّ. لاَ يَكِلُّ وَلاَ يَنْكَسِرُ حَتَّى يَضَعَ الْحَقَّ فِي الأَرْضِ، وَتَنْتَظِرُ الْجَزَائِرُ شَرِيعَتَهُ» (إشعياء ٤٢: ١- ٤)؟ كان السؤال المُحيّر الذي طالما تردَّد في ذهن المعمدان: ألا يرى المسيح الظُلم الفظيع الذي أصابني؟ ألا يعرف المسيح أنّ هذا الظلم كان نتيجة مُباشرة للصلاح الذي عِشته وللحقّ الذي أعلنتُه بشجاعة في وجه ملك ظالم وشرير ومستبيح؟! فكيف لا يمُد المسيحُ صديقُه وابنُ خالته يدَه القديرة لينتشلَه من هذا الضيق والخطر ولو اقتضى الأمر إجراء معجزة؟
ولعلّ المعمدان كان يعتقد أن المسيح سيكون ملكًا أرضيًا جبارًا، يملك من البحر إلى البحر، وينشر العدالة والسلام بين أرجاء المسكونة. ولأن يُوحَنَّا استسلم لهذه الأفكار والتساؤلات فقد استولى عليه الشكُ والقنوط. لقد كان يُوحَنَّا المعمدان إنسانًا معرَّضًا كأي إنسان آخر للسقوط في الخطأ، لذا فبعد أن كان مُتمتّعًا بالحُريّة والحُظوة صار أسيرًا بسبب جرأته في قول الحق، وقادته ظروفُ الأسر المريرة إلى الشك!
ربَّما نلوم يُوحَنَّا المعمدان ولو في سريرتنا، لكن ما أصعب أن يقيَّد الرجل وهو في عزّ قوته وريعان شبابه، لا سيّما بعد سنين طويلة من الهمّة والعمل والإنجاز. لذا ففي يوم من أيام سجنه فرغ صبرُه وخارت عزيمتُه، فأرسل اثنيْن من تلاميذه إلى المسيح سائلًا: « أَنْتَ هُوَ الآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَر؟» هل أنت حقًا مسيا الله الموعود به، أم أن علينا أن ننتظر من سيأتي بعدك؟!
تقابل تلاميذُ المعمدان مع المسيح وطرحا عليه سؤال النبيّ السجين، وبترتيب العناية الإلهيّة كان المسيح قد أجرى معجزات لشفاء الكثيرين في ذات الوقت. ثم قال المسيح: «طُوبى لمن لا يعثُر فيّ». ونستنتج من إجابة المسيح للتلميذيْن أن سؤال المعمدان كان سؤالُا جادًا وحقيقيًا ناتجًا عن شكوك ملأت قلبه وذهنه. لقد شكَّ المعمدان في المسيح بعد كلِّ ما رآه وسمعه. رأى يُوحَنَّا السماوات مفتوحة وسمع صوتَ الآب يشهد لابنه المبارك: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سُررت» (متّى ١٧: ٣) لكنه أمام التجربة المريرة ضعف إيمانُه وشكَّ في هُويّة المسيح!
عزيزي القارئ، هناك شكوك تملأ القلب البشريّ بسبب تمسُّك الإنسان بخطايا مُعيَّنة. هذه الشكوك لا يُمكن الانتصار عليها ما لم يتخلَ أصحابُها عن خطاياهم. وهناك نوع ثان من الشكوك ينتج عن قلّة المعرفة وهذه الشكوك تزول بمُجرَّد زوال أسبابها؛ فحين يطلب المرء الحقيقة لذاتها فإنّه يجدها، وحين يسأل الإنسانُ الله الهدايةَ والإرشاد والرشاد فإنّ الله حاضر ليتكلِّم عن نفسه للبشر. وهناك نوع ثالث من الشكوك التي تهاجم ضمير الإنسان المؤمن وذهنه بسبب تجارب الحياة وآلامها، والأمل في الانتصار على هذا النوع من الشكوك معقود على مُجرَّد «كلمة» تأتي من فم الله مباشرة. كان هذا النوع من الشكوك هو ما أصاب أيوب، بسبب تجربته التي نقرأ عنها في سفره الوارد باسمه في العهد القديم. وهذا هو نفس النوع من الشكوك الذي هاجم ذهن المعمدان هنا. لكن الشيء الجميل أنّ أيوب توجّه بشكوكه إلى الله، ويُوحَنَّا المعمدان لم تبعده شكوكُه عن المسيح، بل بالأحرى ألجأته للمسيح. لقد انتصر الإيمان على الشك في قلب المعمدان، ورغم الخوف والميل الطبيعي لليأس لكن إجابة المسيح القاطعة، المقرونة بالبرهان الدامغ والدليل القاطع، لا بد أن تكون قد أزالت غيومَ الهواجس وسندت الإيمان.
يرى بعضُ الدارسين أنّ المعمدان لم يشُكّ قط في المسيح، بل لقد أراد فقط أن يوجّه أنظار تلاميذه إلى المسيح عند الحصول على جواب لهذا السؤال الجوهري. فإن صَدَقتْ هذا الفرضيّة يكون المعمدان قد استمر في نُكران ذاته، إذ استمر في سعيه لهداية البشر إلى المسيح، الذي شهد عنه يومًا إنّه «ليس أهلًا أن ينحني ليحُل سيور حذائه». وعلى أي حال، لقد شاء الآب السماوي الحكيم أن يموت المعمدان شهيدًا بسبب الحق الذي أعلنه في وجه ملك ظالم، فاستحق المعمدان أن يحصل على مجد مضاعف في الحياة الأبديّة. لقد أعطانا المعمدان نموذجًا فريدًا للخدمة النبويّة التي لا تهاب أحدًا وللجُرأة الدينيّة التي تطيع الله أكثر من الناس، حتى لو كانوا ملوكًا.
بقي أن نقول إنّ المسيح اختار أن يُجيب عن سؤال المعمدان بالأفعال لا بالأقوال: « ففِي تِلْكَ السَّاعَةِ شَفَى كَثِيرِينَ مِنْ أَمْرَاضٍ وَأَدْوَاءٍ وَأَرْوَاحٍ شِرِّيرَةٍ، وَوَهَبَ الْبَصَرَ لِعُمْيَانٍ كَثِيرِين». طلب المسيح من الرسوليْن أن يقولا للمعمدان شهادتهما عمّا رأيا وسمعا خلال خدمة المسيح الشفائية والتعليميّة. ولا شك أنّ المسيح عرف مسبقًا أن يُوحَنَّا (الذي كان آخر أنبياء العهد القديم) سوف يدرك ببصيرته الروحيّة هويّة المسيح، الذي تحقّقت في شخصه وخدمته كُلّ نبوّات العهد القديم.
عن هذه الحادثة قال أحد الدارسين قولًا حكيمًا أنقله لك عزيزي القارئ: «فحين قال يُوحَنَّا المعمدان أسوأ ما يُمكن أن يُقال عن المسيح، قال المسيح عن المعمدان أجمل ما يمكن أن يُقال عن إنسان!» لك المجد يا سيّدي! قال المسيح للجموع بعد أن انصرف رسولا يُوحَنَّا المعمدان هذه الكلمات: «مَاذَا خَرَجْتُمْ إِلَى الْبَرِّيَّةِ لِتَنْظُرُوا؟ أَقَصَبَةً تُحَرِّكُهَا الرِّيحُ؟ بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُوا؟ أَإِنْسَانًا لاَبِسًا ثِيَابًا نَاعِمَةً؟ هُوَذَا الَّذِينَ فِي اللِّبَاسِ الْفَاخِرِ وَالتَّنَعُّمِ هُمْ فِي قُصُورِ الْمُلُوكِ. بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُوا؟ أَنَبِيًّا؟ نَعَمْ، أَقُولُ لَكُمْ: وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِيٍّ! هذَا هُوَ الَّذِي كُتِبَ عَنْهُ: هَا أَنَا أُرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلاَكِي الَّذِي يُهَيِّئُ طَرِيقَكَ قُدَّامَكَ! لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ بَيْنَ الْمَوْلُودِينَ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ نَبِيٌّ أَعْظَمَ مِنْ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَان» (لوقا ٧: ٢٤- ٢٨).
إنّ الله في محبته يُقدِّر ضعفَنا البشريّ، وهو لا ييأس منّا أبدًا. إن كُنّا نلجأ إليه في أوقات تجاربنا العاصفة وشُكوكنا الشديدة فإنّه لا يتركنا أبدًا بل يأتي إلينا. ورغم أن الله قد يختار ألا يجيب عن أسئلتنا الحائرة إلا أنه يبقى هناك مُؤازرًا لنا وداعمًا، وفي نعمته لا يطلب منّا إلا أن نطرح هواجسَنا عنده وهو يعتبر هذه التصرُّف نوعًا من الإيمان به - قياسًا على لجوء الأبناء بأسئلتهم إلى أبيهم المُحبّ. لذا دعونا لا نخشى التساؤل، ولا نرفض السائلين. دعونا ننظر لخِبرة الإيمان على أنَّها «رحلة مع الله وإلى الله» وما الشكوك والأسئلة إلا طريقة للاكتشاف والتعليم.
أخي المؤمن، تعال بأسئلتك إلى الله. تعال إليه بشكوكك، وهو سيرحب بك. لا تدع شكوكك تقودك للبعد عنه. بل ألق على الربّ همّك وأحمالك وهواجسك.